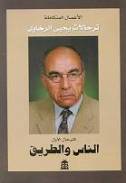|
Arabpsynet |
|||
|
|
|||
الأعمــال المتكاملــة
ترحالات يحيى الرخاوي الترحال الأول - الناس و الطريق الناشر : مطبعة المدينة - 2000 E.mail : yehia_rakhawy@hotmail.com |
|
||
|
|
|||
|
q
فهرس الموضوعات /
CONTENTS / SOMMAIRE |
|||
|
§
المقدمة
§
الترحال
الأول :
الناس و الطريق o
الفصل الأول :
و إلا فما جدوى السفر؟
o
الفصل الثاني :
بعد ظهر يوم سبت حزين
o
الفصل الثالث :
في ضيافة المرأة المهرة
o
الفصل
الرابع
: الحافة و البحر
o
الفصل الخامس :
أغنى
واحد في العالم
o الفصل السادس :
لابد من باريس، و إن طال السفر |
|||
|
q
تقديم الكتاب / PREFACE |
|||
|
تقديــم : يقع هذا العمل ما بين السيرة الذاتية و أدب الرحلات، وكنت أتصور أنني سوف
أنجح أن أصنفه إلى أي منهما. ولم أنجح. الترحال الأول نشر
مسلسلا : أشبه بأدب الرحلات، إلا أنه غلبت عليه تداعيات تتجول بين الداخل
والخارج. كانت رحلة مع رفقاء تتراوح أعمارهم بين سني حينذاك (51 سنة)، وبين
الثامنة. ثلاثة منهم أولادي من دمى: منى و مي ومصطفى، و اثنتان، بنتي عاطفيا
وأدبيا: مايسة ومنى السعيد الرازقي، وطفلان بمثابة حفيدي، هما- أيضا- كذلك:
بالعشرة والجيرة والصداقة معا: علي عماد غز وأحمد رفعت محفوظ. ثم زوجتي الصديقة
الصبور، فوزية داود. طوفنا معا أوروبا بحافلة خاصة،
وخيمة، وقد نشر أغلب هذا العمل في صورته الأولى على حلقات في مجلة "الإنسان
والتطور"، باسم "الناس والطريق"، وكنت قد عزمت أن
أضيف ".. وأنا (الناس والطريق.... وأنا) للعنوان. حين تبينت كم هو
أقرب إلى السيرة الذاتية، لكنى اكتشفت بعد نشر هذا الترحال الأول مستقلا استحالة
كتابه ما هو سيرة ذاتية أصلا. و لأن العمل تغلب عليه طلاقة الحكي
وفرط الاستطراد، فقد فضلت أن أعيد تنظيمه بشكل أتصور أنه قد يعين القارئ على
التحرك داخله مع أنى غير مقتنع بذلك. هذا، وقد عدلت مؤخرا عن نشر
الترحالات الثلاثة في مجلد واحد، حتى لا أفرض نفسي على من لم يستسغ بعضي، فكانت
هذه الكتب الثلاثة لمن شاء أن يكتفي بأي منها، على أن أجمعها لاحقا لمن شاء أن
يحتفظ بها معا. و في حين يغلب على الترحال الأول
تداعيات ابن سبيل مع الناس على الطريق، فإن الترحال الثاني يغلب
عليه الاتجاه العكسي من الداخل إلى الخارج (وبالعكس) وأيضا من القبر إلى الرحم
(وبالعكس). ومن ثم كان الاسم " الموت والحنين"، أما الترحال
الثالث فهو اكتشاف لاحق لملامح من ذاتي كتبت دون قصد كشف ما كشفت، فبدت لي
أكثر مصداقية وأشجع بوحا، فكان ما أسميته "ذكر ما لاينقال" أعتقد أن اسم "أدب المكاشفة" أقرب
إلى هذا العمل من "أدب الرحلات" أو "السيرة الذاتية"
أو حتى "أدب الاعتراف ". |
|||
|
q
الفصل
الأول : و إلا فما جدوى السفر؟ |
|||
|
... وإلا، فما
جدوى السفر؟ "...
وأخرُج بين
الحين والحين إلى سطح السفينة، لأجد البحر، أصل كل شىء، وقد احتوانى من كل جانب..
أفتح وعيى
للانهائى، فأتلاشى بإرادة
أعمق، وتتضاءل الأفكار والطموحات، ويخفت الغرور، ليرفرف الشك - دون رفض - على ما فات.
ولـِمَ لا ؟ ؟ قبيل 21 أغسطس
1984: لظروف خاصة،
وفاء لوعد قديم، قررت أن أقوم بهذه الرحلة المحدودة (رحلة الأسابيع الأربعة)،
فالتمست لها هدفين، علّهما يخفيان ـ ولو عنّى ـ الدافع الأصلى: أولهما: تجديد
الوعى بمثيرات طازجة عهدتُها مع التَّرحال. وثانيهما: التعرف على أولادى أكثر،
فى محاولة جديدة لكسر الوحدة. قبل أن تبدأ
الرحلة، تيقّنت من فشل الهدف الثانى؛ حيث أُجهض فى محاولات تمهيدية، وذلك حين
تبيّن لى حجم المسافة التى بينى وبينهم، وأن هذا الهدف، الاقتراب الذى أنشُده،
هو نوع من الحلم الخاص المتكرر، حلم يطفو على السطح فى أوقات الضعف القهرى، حين
أكون أقرب إلى اهتزازى، وفى الوقت ذاته، أكثر وعيا بطبيعة نهايتى كفرد؛ فأستشعر
الموت يزحف فى يقين الواثق من غلبته فى النهاية، فأعمّق وعيى به، وإذا بى أندفع
نحو الآخرين بشغف أكثر، وحاجة أشد.فى هذه المرة، تصوّرت أن الفرصة متاحة
للاختلاء بأولادى بعيدا عن رتابة العلاقة الفوقية من جانبى، والاعتمادية من
جانبهم. إلا أننى قبل أن نبدأ أدركت ـ بلا جديد ـ أن محاولة عبور مثل هذه
المسافة، بينى وبينهم، قفزاً أو قسراً، ليس وراءها إلا أوخم العواقب، فتراجعت. لم يبق، فى
ظاهر الأمر، إلا الهدف الأول. تـُـرى هل هو هدف أم نتيجة مرجوّة؟
قبل أن
أستطرد، أستأذن القارئ فى الحديث عن ظروف كتابة هذا العمل: فما دعانى إلى ذلك
إلا ورطة جديدة تتعلق بما وعدت به من إكمال كتابة موضوع "ماهية
الوجدان"؛ لنشره فى مجلة "الإنسان والتطور. كنت قد وعدت بذلك مرارا
ولم أفِ بوعدى، فتصورت أن فى هذا السفر فرصة للنظر الأعمق، والترتيب الأنسب،
وذلك بفضل بعدى عن العمل اليومى (المزدحم بالروشتات، والتليفونات، والإلحاح،
والعدَّ، والمشورة، والمجامـلة، والأهداف الصغيرة، الجيدة، والقبيحة). هكذا
أوهِمُ نفسى أبداً: بأننى قادر على إكمال بعض كتاباتى العلمية، والأدبية
المتوقفة، حين أبتعد؛ ربما لأبرر لنفسى حق الترويح والانطلاق، وربما لأن السفر
فعلا يسمح بذلك، حيث يسمح بنوعية مختلفة من اليقظة القادرة على التنظيم
والتسجيل. وتذكرت طه حسين وهو يكتب كتابه الضخم المهم عن أبى العلاء فى أعلى
جبال الألب "شامونى"، قلت إن طه حسين قد اقترب من أبى العلاء كل هذا
القرب حين فرّ به بعيدا عنا، فلمَ لا أحذو حذوه لعل الله يفتح على قلمى فينجز ما
وعد؟ (واقع الحال
أننى رجعت من الرحلة وأنا لم أخط حرفا عن مسألة الوجدان هذه كما وعدت، وحتى الآن يوليو 2000.
بعد عودتى، رحت أحكى لزملائى فى المجلة بعض ما مرّ بنا فى هذه الرحلة، وطبيعة
إيقاعها مما حال دون وفائى بوعدى، فاقترح علىّ بعضهم - تعويضا أو عقابا - أن
أكتب هذا الذى حكيته لهم فى المجلة. قلت أجرّب. فكان ما ظهر بعنوان "الناس
والطريق" فى المجلة عبر سنوات، وهو ما يشغل التّرحال الأول وبعض التّرحال
الثانى من هذا العمل). حملتُ كتبىِ
وناسىِ ونفسىِ وتوكلت. تفتحت مسامى. عرفت أننى فى حالة انتظار إيجابى لأمورٍ
تستأهل. علاقتى بالكتب
حالة كونى مسافرا تحتاج إيضاحا خاصا. فأنا أشعر أنى بغير كتاب فى صحبتى، كالذى
يمشى عاريا فى شارع مأهول بالغرباء. ودائماً آخذ معى من الكتب ما يثقل الوزن حتى
يهدد المسموح به فى الطائرة، وقد تضيق بذلك زوجتى (سراً عادة)، وقد تتوقع ـ لا
شعوريا فى الأغلب ـ أن يكون هذا الثقل على حساب ما تأمل فى شرائه، على الرغم من
وعدها بغير ذلك. أنا لا أطمئن إلا وفى صحبتى عدد متنوع من هؤلاء الأصدقاء الكتب،
ثم إن السفر هذه المرة كان بالباخرة، ومعى حافلة (أتوبيس-ميكروباص) صغيرة، فلا
مشكلة وزن أو حجم شاذ، ذهابًا وعودة، ولا تنافس بين كتبى ومشترياتها. فأعددت
حقيبة مستقـلة للكتب، وبها من المراجع ما يلزم. لكننى، ولأول مرّة، وجدت نفسى
أفتحها عنوة ليلة السفر، بعد تيقنى من خبرتى السابقة، وطبيعة المسافة التى
تنتظرنى لأقطعها قائدا الحافلة الصغيرة، أننى لن أستطيع أن أمس هذه الكتب طول
الرحلة. فى حسمٍ مؤلم: تركت الحقيبة بما فيها مغـلقة، لكننى استدرتُ فمددت يدى
إلى ملحمة حرافيش محفوظ، وجمعت البطاقات التى كنت قد سجّلت عليها ملاحظاتى على
هذه الملحمة، وقدرت أن يمكننى أن
أرحل فى زمان هذه الملحمة حالة كونى مرتحلا فى أرض الله الواسعة، ويا حبذا لو
صحبنا جارثيا (مائة عام من
العزلة)، فحملت الملحمتين معاً، وقلت لعلى واجد فيهما ما يصلح للمقارنة أو
الإلهام بالتبادل. تذكرت علاقة
نجيب محفوظ بالسفر، ففهمتها أكثر؛ إذ يبدو أن أستاذنا يقنع ويثرى " بالسفر
الداخلى" المتصل، الذى نصاحبه فيه أطول وأعمق. السفر الظاهرى قد يكشف أو لا يكشف. تذكرت له حوارا يقول فيه
إنه لا يميل إلى السفر ولا يسعى إليه، ولكنه إذا فُرض عليه لظرف أو لآخر، فإنه ـ
بعد رهبة البداية ـ يجد نفسه متطهراً متجدداً، أو مثل ذلك. تذكرته وفهمته أكثر
فأكثر، وأنا أنظر فى نفسى (أُنظر
أيضا الترحال الثالث إن شئت). أنا
أقيم حتى أشعر أنه ليس ثَمَّ داع لأىة حركة أخرى. فكل شىء هنا فى مصر قائم جاهز
متاح، بل هنا فى حجرتى على مكتبى، فلماذا شد الرحال، فإذا ما سافرت تقلّبتُّ حتى
فزعت من نظرتى الساكنة ـ حالة كونى مقيما ـ لـِمَا كنت أظنّه الدنيا (داخليا ـ
وخارجيا)، فالقعدة المغلقة تهددنى باحتمال التسليم إلى االاستكانة الغامضة،
والأفكار الثابتة، و ضعف الحوار مع الناس والطبيعة، وكذا تلوّح لى بأوهام
التفوق، وتغرقـنى فى عاديّة المشكلات، واحتمالات خبث التنافس، وأوهام أحلام التطور
(الـخاصة والعامة)، كل ذلك يتبدى لى بأثر رجعى ـ متى سافرت ـ أنه كان قد أحاط
حياتى بإيقاع شبه ثابت، مما يعرضنى عادة لـلبعد عن "الآخر" الحقيقى،
ولاحتمال التعصب المعلن أو الخفى، وهكذا: كلما
ألقيت بنفسى ـ أو ألــقِىَ بى ـ فى الطريق، خارج النفس الغالبة، وخارج الديار،
رحت أعيد النظر فى نفسى وفى الناس - لا كما رسمتُهم لنفسى ولا كما اعتدت عليهم،
فأستسلم لاقتحامهم الرائع،
فأتجدد. ويتحرك الوعى إلى ما يمكن. ليكن. وليكن
من بين ما يتحرك هذا القلم بيدى. فهل يا ترى
هذا هو ما يسمى "أدب الرحلات؟ أدب الرحلات
أدب حديث قديم، وصورته الحديثة آخذة فى التقدم بين صنوف الأدب، أصبح نشاطا أدبيا
مستقلا. ومنذ رفاعة الطهطاوى حتى خيرى شلبى، وأوربا بالذات تحظى بنصيب وافر من
انبهار واعتراض من كتبوا هذا النوع من الأدب من أدباء مصر. وفى تصورى أن كتابة
الرحلة بصفتها أدباً هو من قبيل السيرة الذاتية أكثر منها نوعا من وصف المدائن
والناس، وبالتالى يسرى على هذا النوع من الأدب، ما يسرى على السير الذاتية من
تحفظات. كتابة السيرة
الذاتية مستحيلة أصلا، على عدة مستويات، فالشخص الذى يجرؤ على هذه المحاولة هو
محكوم عليه برؤيته أولاً. ورؤيته ليست مرادفة لما "هو"، وحتى صورته
التى غامر فرأى ما أمكن منها ليست دائما صالحة "للإذاعة" والنشر، فهو
يُخضع هذه المحاولة لأحكام المجتمع، وقيود الفكر ومرحلة التاريخ، فضلا عن قيود
النشر (فى بلادنا خاصة). هذا، لـو أنه وُهـِب الشجاعة لـقول مارأى، وأيضا لو أنه
وُهـِب البصيرة لرؤية ما هو كائن فعلا، وليس مجرد تصوره عن نفسه. ومن هنا، ينبغى
أن نعتبر أن أية سيرة ذاتية، ليست إلا "وجهة نظر"، بل إنها ليست إلا
"وجهة النظر المسموح بإعلانها" فى حدود ما يسمح صاحبها، وما يسمح
الناس، لا أكثر. كتابة السيرة
الذاتية فى بلادنا العربية ـ بشكل خاص ـ أمر غريب على طبيعتنا، وعلى عاداتنا؛
حيث لا يُظهرالكاتب ـ أى كاتب ـ من نفسه إلا مواضع الفخر والتفوق، فإذا أظهر
ضعفا أو خطأ أو تشوها أو انحرافا.. فإنه إنما يفعل ذلك ليعلن بعده مباشرة أنه
إنما " عرف الشر لا للشر لكن لتوقّيه!!" (ومن لا يعرف الشر من الخير
يقع فيه!!). مصطفى محمود يعلن إلحاده حين يصل إلى بر الأمان، والإيمان. أنور
السادات (يجزيه الله خيرا، ويسامحه) يكتب قصة حياة خيالية يبحث فيها عن ذاته
(البحث عن الذات)، فيشط به الخيال حتى يصدقه نفسه، ويفرضه علينا. جمال عبد
الناصر (يرحمه الله، ويغفر له) لا يشط إلى هذا المدى. وإن كان ما كتبه عن نفسه
قليلاً وسطحىاً، فإن ما كتبوه عنه قد أرضاه حيّا (غالبا)، وآذاه ميتا، أو قدّسه
"أملا أو حلما "حتى نفاه "شخصا"، ثم طه حسين، والعقاد،
وتوفيق الحكيم، ومصطفى أمين، حتى محمد حسنين هيكل، كل أولئك كتبوا صدقا وأمانة
وخيالا وأحلاما معا، وبعضهم وثـَّق ما يقول بوثائق لا تثبت حقيقةً ، ولا
تنفيها(عادة). أديب السفر
يعامَل باعتباره أديبا، لا مؤرخا، ولا رحالة مسجِّلا، فهو يكتب نفسه ابتداء،
وينجح ـ مثل كل أديب ـ بقدر ما يستطيع أن يعرِّض نفسه لـلتجارب، وبقدر ماتسمح له
مسام وجوده باستنشاق الآخرين، وبقدر ما تتيح له مرونة أفكاره بإعادة النظر
وتفجير شرارات التغيير من خلال تصادم الاحتكاك، وبقدر ما يستطيع أن يصوغ كل ذلك
بأدوات مهارته، حالة كونه مسافراً. أما السفر
الذى يسجـِّل الأحداث العابرة، ويصف عادات من يلقاهم هنا أو هناك، وكأنها العادة
المتأصلة فى هذا "الشعب" أو ذاك!! فهو عادة ما يقع فى خطأ المبالغة فى
التعميم، وكأن من قابله الكاتب مصادفة (فى الأغلب) هو "ممثل نموذجى"
للبلد الذى زاره. عجزتُ دائماً عن فهم كيف يحكم كاتبُ رحلة على شعب بأكمله؛ لأنه
التقى بنادلٍ فى مقصف صفته كذا، أو قابل صاحبة فندق شكلها كيت، أو بائع تحف، أو
فتاة هوى التقى بها بضع دقائق أو بضع ساعات، ثم يجرؤ أن يقول: أما الرجل السويدى
أو المرأة الفلبينية فهو كذا أو هى كيت...إلخ. كما أنى عجزت عن فهم كيف يعتبر
كاتبٌ ما أن قـُطراً ما هو عاصمته، أو هو أكبر مدنه، أو هو أشهر آثاره، فى حين أن
نبض الشعوب، وأصالة الفروق بين ناس وناس لا تظهر إلا كلما ابتعدنا عن المدن
عامة، والعواصم خاصة. ولنا أن نتصور أن كاتباً أجنبياً قابل مواطنا مصريا من
الزمالك، وآخر قابل مواطناً آخر من عزبة القصيّرين (فى غمرة) أو من منشاة الجمال
مركز طامية، أو من أم قمص (جمّص) مركز مـلوى، أو كفر عليم مركز بركة السبع، فكيف
يصف أى من هؤلاء من قابله باعتباره "الرجل المصرى" النموذجى، وأنه
يمثل طبيعة "الشعب المصرى"،.. وهات يا كتابة، إن أغلب زوارنا العرب ـ
مثلاً ـ لا يعرفون من مصر إلا حى المهندسين، وشارع الهرم، ومصر الجديدة على أحسن
الفروض. ومع علمى بكل
ذلك، وبسبب علمى هذا، أقدمتُ على هذه المغامرة بالكتابة فى هذا النوع من الأدب،
وأنا خائف من كل ذلك، مشفق على قارئى من أن يأخذ كلامى مأخذا لم أقصد إليه، فأنا
أتصور أنى لا أكتب إلا استجابتى الشخصية المحدودة لمؤثرات جديدة، ومتلاحقة، لا أكثر
ولا أقل. وما الأحكام والآراء والرؤى الواردة فى هذا العمل خاصة إلا زاوية
محدودة لرؤية كاتب يحاول أن يكون يقظا فى استيعابه وتمثله لما رأى من ناس وطبيعة
وأشياء، وقبل ذلك وبعد ذلك، لما رأى فى نفسه، ومن نفسه. هذا السفر
الذى أنتزع نفسى إليه، أو ترغمنى الظروف أو المصادفات عليه، هو الذى يحرك وعىى
إلى حيث لا أعلم. اكتشفتُ بمحض الصدفة أنّ أكثر من نصف ما كتبته مما قد يسمّى
شعراً، كتبته فى "حالة سفر"(أنظر الترحال الثالث إن شئت). استطعت أن
أرجح من خلال ذلك أننى بمجرد أن أتخلص من الإغارة السرية المتسحبة المستمرة على وعيى
بالمؤثرات الرتيبة الباهتة، وأيضا بالضغوط الملحّة الجاثمة، تتفجّر من داخلى
الرؤى المؤجَّلة، والمهمَــَََلة، والكامنة، والعنيدة، فأعيد تنظيمها
"لأقول" بالأداة التى تحضرنى. انتبهت من كل
ذلك إلى وظيفة السفر عندى، وقلت لعل ورطتى فى سفرتى هذه، تكون فرصة جديدة أتعرف
من خلالها على بعض أبعادى، لا على بعض أولادى كما تصورت أولاً، وأمِلتُ -ربما
كبديل - أن أسمح لبعض نفسى، مما أعرف ومما لا أعرف، أن تنساب منى، وأنا أجرب هذه
الأداة الجديدة، والتى قد تسمى أدب الرحلات ستراً وتحايلاً، وإن كانت قد انتهت
لتكون أقرب إلى السيرة الذاتية، أو لعلها تتراوح بين هذا وذاك، فهى ترحال بين
الداخل والخارج طول الوقت، (ثم تطور الأمر لأسميها "أدب المكاشفة"،
وليس حتى "أدب الاعتراف").
أنا شديد
النفور من أغلب أنواع السفر الأخرى، لا أكاد أعرف لها معنى يبررها، مهما بلغ
حماس أصحابها لها. لا أفهم أسفار
المشتريات الاستهلاكية، ولا أسفار المؤتمرات العلمية (شبه العلمية). بل إننى لا
أفهم أسفار السياحة بمعنى زيارة التاريخ والآثار؛ حيث يكون الهدف الأهم هو
التجوال "حول الأطلال" و "داخل المتاحف". كم من مرّة مازحتُ
فيها مرافقىّ فى بعض أسفارى، ونحن نزور الأماكن "المقررة" (مثلا:
عمارة الإمپاير ستيت أو تمثال الحرية) فأقول ونحن نلتقط الصور بجوار هذا
المَـعـْلمِ أو ذاك: "وهكذا تم التوقيع فى سجل تشريفات "سيدنا الأثر
"الفلانى" بعد دفع المعلوم فى صندوق النذور"، فلزم التنويه!!.
حتى إذا سأَلـَنا سائل عند العودة عن هذه الأماكن، أو إذا ذُكِــرَتْ أسماؤها
بانبهار أمامنا، شاركنا بإيماءةِ رأسٍ أو نظرة أُلفة، وبالتالى ننضم ـ ولو
منتسبين أو أعضاء شرف ـ إلى فصيلة من يعرف هذه الأسماء المشهورة التى يدور حولها
الأكابر والمثقفون والساسة المسافرون فى فخر وزهو فوقيّـين. نعم، كل هذه
الأسفار لا تستأهل لدىّ شد الرحال، ومع ذلك فإنه حتى لو شاركتُ فى مثلها لبضعة
أيام، فإنى أمارس خبرة تفجير الداخل، وتفتح المسام، بطريقة تجعلنى أعود ـ حتى
رغما عنى ـ مهزوزاً منتعشاً مفكِّراً أبحث عن بدايات جديدة، أو أعيد وزن أفكار
قديمة، أو كليهما. حين كنت فى
باريس (1968/1969)، فى مهمة علمية، (هكذا يسمّونها) تعلمت من الفاقة والنشاط أنه
لا يعرف المرء بلدا إلا إذا مَشاها، ما إستطاع، على قدميه، شارعا شارعا، جالسا
على مقاهيها (بالذات) ما طال له الجلوس، متأملا، مشاركا فى كل حين، بقدر ما
تمكّنه اللغة وتحفزه الدهشة. حتى أنى كنت- أحيانا أرحب بالتوْهِ وفقد المعالم،
وأتلكأ فى إخراج الخريطة؛ مادمت أسير حيث لا أدرى، فأعيش كما لم أحسب، وألاقى من
لم أتوقع، وقد كدت أصبح فى نهاية العام الذى قضيته هناك شيخ حارة باريس بالنسبة
إلى زملائى فى أعضاء المهمة العلمية المزعومة، وأيضاً بالنسبة إلى بعض الأصدقاء
الذين يحضرون إلى باريس عابرين. كان من بين ما يستهوينى أن أذهب من أقصى الشمال
حيث أسكن فى المونمارتر، إلى أقصى الجنوب حيث أعمل فى مستشفى سانت آن، مخترقا
ميدان الأوبرا، عابرا السين، ثم محاذيا له، ثم مخترقا الحى اللاتينى حتى أصل إلى
محطة جلاسيير (الحى -الدوّار الـ- 13). يستغرق ذلك عادة أكثر من ساعتين أستمتع
بكل دقيقة منهما. لا يمنعنى من ذلك مطر أو برد، بل يزيدانى انتعاشاً، وأعيد
أثناء ذلك تأمل كل شىء، وكأنى أراه من جديد، فأشعر بالدفء والقدرة. وكانت نـشوتى
تزداد فى أيام الشتاء مصحوبة بقدر مناسب من التحدى وأنا أواجه الـصقيع، أتحسس
أنفى فلا أجده، وكنت أتساءل : مِن أين جاءنى هذا الحب العارم لـلشتاء والمطر
والصقيع، وأنا ابن التراب والحر والعرق والتلوث المصرى الأصيل؟. أتذكر كيف كان
جارثيا يفضل (أو يصر) أن يكتب رواياته أثناء تواجده فى باريس فى نفس درجة حرارة
بلده القائظ، وأعجب لارتباط كتابته بما أتصوره من عرق وأنفاس ثقيلة. لكننى عكسه
تماما، أسارع فأحتضن اللفحات الباردة المثيرة، وأمضى أحسد هؤلاء الناس فى جميع
الأحوال، وأقول لنفسى: إن بعض الكسل الذى يثقل خطانا وتفكيرنا ـ فى بلدنا ـ قد
يرجع قليلاً أو كثيراً إلى المناخ الحار المغبر الذى يخدرنا ضمن بقية المخدرات
الحديثة والقديمة. لكن سرعان ما أراجع نفسى ـ دون أن يخف حقدى عليهم ـ فأقول:
".. ولو، فنحن قادرون، أو ينبغى أن نقدر، على أن نخترق أجواءنا إذا أحسنَّا
تحديد الهدف، وضبط الإيقاع، ومواصلة التحدى"، وأعرف أننى أضحك على نفسى
(غالباً). أقول إنى لم
أعرف باريس ـ أو غيرها ـ إلا سائرا على قدمىّ، وما سخرت ملء عقلى، إلا من هذه
الجولات السياحية التى اضطررت فيما بعد إلى المشاركة فيها؛ حين كنت أزور بعض
البلاد فى عجالة، تلك الجولات التى يسمونها "الرؤية السياحية العابرةsight
seeing "؛ حيث تجلس فى حافلة
(أتوبيس) مكيفة الهواء، ويحكى لك السائق، أو المرشد، أسماء الأماكن والشوارع،
والمعارك، والقُوَّاد. تيقنت من
موقفى هذا، أثناء إحدى الجولات حول مدينة بوسطن، فى صيف العام الماضى، حيث شعرت
أنى أشاهد فيلما تسجيليا رديئا لا أكثر، لولا أن أنقذنا السائق بوقفةٍ فى
"ركن الشاى". فى سفينة تاريخية تؤرِّخ لبدء تحرير الولايات المتحدة من
الشمال، بإعلان الثورة على زيادة الضرائب على الشاى، من قِبَل الحكومة
البريطانية المستعمِرة. الشعور نفسه راودنى بدرجة أقل فى سان فرنسيسكو، لولا
تنوع الطبيعة، وخفة ظل المرشد، وركن الشاى اليابانى (مع الفارق بين ركن شاى وركن
شاى!!). خرجت دائما من
المقارنة بين الجولة على الأقدام ضائعا داخل المدينة، والجولة داخل حافلة سائحين
مع مرشد، أنه: لا سبيل إلى معرفة الناس من وراء زجاج داخل حافلة سياحية مكيفة
الهواء، وأنه لا سبيل إلى مغامرة معرفة النفس ـ بالسفر ـ وأنت تتلقى معلومات
جاهزة، وفكاهات مكررة، من مرشد موظف. لذلك فإنى رجّحت، أن الإيقاع البطىء فى
السفر هو أساسٌ لا غنى عنه لمن يريد أن يعرف الأمكنة والناس، من خلال انصهاره
بها: تمشى وتسأل. تمشى وتتوه. تمشى وتتعب، فتجلس فى المقهى الأقرب أو البستان
الأجمل أو محطة المترو الأدفأ أو الأبرد. تمر ببائع الزهور والصحف والفاكهة
واللحوم والدجاج المشوى و "الآيس كريم"، وألعاب الحظ، فلا يفوتك تعبير
الوجه ومساومات الشراء، وإغراءات الجذب الصغيرة، وطباع الناس البسطاء. يدخل كل
ذلك إليك عبر أرضية وعيك، حتى لو وجَّهوا بؤرة انتباهك إلى شىء آخر، أكثر تفاهة
ـ فى العادة ـ رغم ظاهر أهميته - التاريخية مثلا. هذا بالنسبة
إلى داخل المدينة. أما بالنسبة إلى التنقل بين البلاد وبعضها، فما أعظم الطائرات
وأسخفها. هذه الثورة التى جعلت العالم قرية صغيرة، هى هى التى حرمت المسافر (ابن
السبيل) من الاستيعاب البطىء للنقلة الجغرافية / الحضارية / الثقافية، التى هى
ثروته الحقيقية وحصيلته الباقية من أى سفر. إن هذه الحركة بالسرعة البطيئة هى
المسئولة عن نقلات الوعى وتقلب المشاعر، ومن ثَم تجَدُّد الأفكار واتساع الأفق،
أما أن تضع نفسك فى طائرة حديثة، ثم تجدك بعد ساعات تقل أو تكثر، فى بلد غير
البلد، مع تشابه الخدمة والمطارات والإجراءات وفنادق "العواصم"، فهذا ليس سفرا. أتذكر أول
قصّة قرأتها: وكنت لم أبلغ العاشرة، وجدتها فى مكتبة والدى باسم "الشيخ
الصالح". لا أذكر مؤلفها، ولا تفاصيلها الآن. أذكر أن الغلاف الخارجى
والورقة الأولى لم يكونا هناك (عكس ما وجدتُ عليه ثانى رواية وقعت فى يدى: كان
اسمها "أزميرالدا" (فى
الأغلب). كانت رواية الشيخ الصالح هذه تدور حول رجل "شيخ" ظاهر
التقوى، ينتقل من بلد إلى بلد على بغلة، ويجرى وراءه طول الرواية
"عبدٌ"حافى القدمين، ونكـتشف ـ فى النهاية ـ أن هذا الشيخ ليس سوى
قاطع طريق. حضرتنى هذه الصورة بوضوح شديد، حتى أننى تذكرت أنى حين تقمّصتُ بعض
شخوص الرواية، لم أتقمص إلا ذلك العبد دائم العدو وراء سيّده!!. وكم أحسست بحبات
كالعرق يتفصد بها جبينى وأنا فى حالة التقمص هذه، وأنا لا أكف عن الجرى وراء
سيدى "الشيخ النصاب" لحراسته، وخدمته، دون شكوى أو تعب. أما رواية
"أزميرالدا" فلم يبق فى ذاكرتى منها إلا صورة بطلها وهو يقطع حجرة
التدخين ذهابا وجيئة مئات المرّات. الحجرة تقع فى جانب بعيد من حديقة قصرٍ ما،
وهذاالذى تبقَّى لا علاقة له بالتدخين، وإنما بخطى هذا الشخص ذهابا وإيابا طول
الوقت. لماذا "ذهابا وإيابا"،"ذهابا وإيابا" بالذات؟ لا
أعرف. (سوف أعرف). ثم يقفز فكرى
إلى تداع آخر، فأفهم لماذا كان "ابن السبيل" (فى فقه الإسلام وآدابه)
أهلا لـلصدقة والزكاة والبر، مهما كان موسِرا فى الأصل، قادرا فى موطنه وبين
أهله. تذكرت ما كنت
أسمعه عن جدى لأبى وهو يرسل رجاله إلى
كل الطرق المارة ببلدتنا، أو حولها، يدعون المسافرين، أبناء السبيل،
(وخاصة بعد عصر أيام رمضان) إلى النزول ضيوفا للإفطار والنوم، ولايجوز البدء فى
الأكل (خاصّة ما نابهم ـ "منابهم"ـ من نصيب فى اللحم) إلا بعد عودة
هؤلاء المندوبين بالضيوف أو بدونهم، فيطمئن جدى وصحبه إلى أن أحدًا لم يعبر
منطقتهم وهو جائع، أو مُجهد، أو بلا مأوى. ثم يأكلون: "منابهم". فهمتُ كل ذلك
من جديد، وعرفت كم كان السفر قاسيا ومرعبا قديما، ولكنى ما رضيت أبداً عن أن
نستبدل به ـ تماما ـ كل هذه الرفاهية بهذه التكنولوجيا الفائقة من طيران وتكييف؛
لأن ثمن ذلك هو أن ننسى الطريق أصلا، الطريق خارجنا، الموازى والمؤدى إلى طرق
الداخل المتعـِـبة، والرائعة، والمتشعّبة. (ربما لهذا ابتدعوا مؤخرا ما يسمّى مغامرات
"سفارى". من يقدر عليها؟). جاء قدرى
الجميل هذه المرة، أن تكون رحلتى هذه بالباخرة، والسيارة، مع صحبتى هذه من
الأصدقاء والصديقات فى هذه الأعمار المتباعدة المحرِّكـة، فاستبشرتُ خيرا،
وانتظرت الجديد.
أثناء وجودى
فى فرنسا أيضا ذلك العام، قمت
برحلات قصيرة كل نهاية أسبوع، وصلت إلى أسبوعين أحيانا، كان، بعضها بالسيارة
الصغيرة مع الإقامة فى الفنادق الشديدة التواضع (نجمة واحدة، أو أقل إن وجد ما
هو أقل) أو التخييم فى المخيمات المعدة لذلك، هذا فضلاً عن الرحلات الجماعية
بالحافلات الكبيرة مع زملاء المنح من العالم الثالث (ضيوف فرنسا آنذاك 1968). كل ذلك علّمنى
ما هو سفر.
إذا كان المشى
هو السبيل الأمثل لمعرفة داخل المدن، فإنه لا بديل عن السيارة للتعرف على
الطبيعة والحوار معها فيما هو بين المدن وبعضها، وبين القرى وحولها، ثم إنه لا
سفر دون إطلاق عنان التداعى الطليق لزيارة داخل النفس المهجور أو المنسى، يتم
هذا أو ذاك بعيدا عن العواصم والحوانيت العملاقة (السوبرماركت، والمُولاَتْ!!)
التى تلتهم الوقت والوعى والنقود والانتباه جميعاً، وأيضاً بعيداً عن وصاية
المؤسسات الفكرية، والعقائدية، وعن غلبة الذاكرة الحاضرة المسطّحة. فإذا كنتَ أنت
قائدا لـلسيارة الساعات الطوال، وجدت نفسك فى حالة من الانتباه تفرض على بصرك
ووعيك ووجودك ـ فى نهاية الأمرـ تفاصيل مناظر الطبيعة المتلاحقة، بما فى ذلك
سباق الناس على الطريق، وأنواع حمولاتهم، وحوارهم بالأضواء والإشارات، وأماكن
انتظارهم، ثم دورات الراحة فى الموتيلات والمطاعم والمعسكرات. كل ذلك يعيد إليك،
أو يعرّفكَ بمعنى "ابن السبيل"، وإن اختلفت الوسائل واللغات. فإذا
سمحتَ، أو حتى إذا لم تسمح، فسوف تجد نفسك فى رحلات الداخل الموازية، حين تعود
إلى طبقات ذاتك وناس عالَمك، وحوارات زمانـك، فتزورها أو ترتبها أو تتبينها من
جديد، فتُفَاجأ بما لم تكن تحسب. 21 أغسطس 1984: إلى ميناء
الاسكندرية؛ لأستقل الباخرة بحافلتى الصغيرة، ومعى زوجتى، دون بقية أفراد الرحلة
من أولادى الذين سبقونا بالطائرة إلى أثينا. الإجراءات غير معقدة، على الرغم من
أن بعضها لم يكن ذكيا تماما. رحت وأنا أنتظر دورى للدخول بالسيارة إلى المركب،
أتعرف على زملائى من المسافرين بوسائل انتقالهم الخاصّة مثلى، فوجدتُنى لا أشبه
أيا منهم فى شئ. فثـَمَّ رجل
أشقر، فى غاية الأناقة والرقة، قد تخطى وسط العمر، يصحب زوجته (أو من تقوم
مقامها، من أين لى أن أعرف) كما يصحب كلبه فى عربة مجهزة للرحلات (كارافان، منهّ
فيه!). عربة هى والقصر المتنقل سواء. لا. ليس هذا. لسنا هما. وثمة عربة
"جيب"(أو كالجيب)، قوية الملامح، جسيمة التواجد، واثقة من نفسها كأنها
تقود راكبها، وليس هو الذى يقودها. يمتطى صهوتها فتى وفتاة بلغ من تراكم التراب
المختلط بالعرق بالبقايا، على جسديهما وملا بسهما، ما يوحى بأنهما خاصما الماء
والصابون طوال رحلتهما التى لاتبدو لها بداية ولا نهاية. وأكاد أحك جلدى نيابة
عنهما، وأقول: ولا نحن مثل هؤلاء. وثمة مجموعة
من "الموتوسيكلات" تربو على العشرة، أصحابها بين فتيان وفتيات، كلهم
فى فتوة الفرسان، وعلى من يستكثر على المرأة الفروسية أن يلبس عينىّ فى تلك
اللحظة، ليدرك معى أن هاتيك الفارسات بعضلاتهن التى لم تنتقص من أنوثتهن شيئا،
وبوجوههن الحاسمة الرافضة كل سلبية أو اعتمادية، هن فارسات بكل ما تعنى الكلمة.
فأين نحن- مصريين ومصريات ـ من الفرسان والفارسات والفروسية والشباب؟ وأنظر فى نفسى
لأجدنى شخصا يقاوم الاستسلام وهو يطرق أبواب العقد السادس من عمره، وهو يجرّب من
جديد بعض ما يمكن، ببعض ما توحيه إليه أفكاره التى أتعبته بقدر ما صدّقها. ألمحتُ فى
البداية أن بعض ما ورّطنى فى هذا الآن كان وعدا قديما لأولادى، ظللت أؤجّل
الوفاء به تسع سنوات، حتى خطر ببالى أن الظروف قد سمحت، وبهذه الصورة. وحين
اكتمل الإمكان بدأ التنفيذ، بغض النظر عن لياقتى الحالية، وما طرأ من تغييرات
بمرور السنين، أعرف هذا النوع من المآزق: أن يعيش شخص مع أفكاره؛ باعتبارها
واقعا ممكنا، ما دامت تبدو مفيدة أو واضحة. فيخاصم المنطق العام أو المألوف، وهو
يحسب أن منطقه واضح بسيط مباشر، أكثر بساطة من كل ما يتصورون. وأنا أعرف أن من
أهم مشاكلى، أننى أصدّق نفسى، وأتصور دائما احتمال تحقيق شطحاتى على أرض الواقع،
وأتذكر كيف تورط فى مثل ذلك جوزيه أركاديو الكبير فى مائة عام من العزلة، حين
راح يترجم أفكاره أولاً بأول، إلى مخترعات وأدوات، حتى خلق عالما
"واقعياً"من الضياع الحالم، والحقيقة الواعدة معاً. أرجع إلى نفسى
وأقول: ولو.. الحمد لله. لم أصل إلى هذه المرحلة القصوى بعد، ولا حتى إلى علاقة
سارتر (فى بداياته على الأقل) بـ "الكلمات". ربنا يستر. مازلنا فى 21
أغسطس 1984: فى الباخرة
الإيطالية، وأثناء تغيير العملات، يقف أمامى رجل أسود فى منتصف العمر، يتكلم
الإنجليزية بلكنة أمريكية، ويمسك بيده رزمة كبيرة من الأوراق الماليّة المصرية
يحاول تغييرها، فيحاول المسئول فى الباخرة، أن يُفهمه استحالة التعامل بالنقد
المصرى خارج مصر(لاحظ التاريخ 1984) وأفهم من الحوار أن ثمة تعليمات غير واضحة
قد وصلت إلى الأمريكى، فأحاول مبادرا أن أدافع عن الاتهامات التى تبادلها مساعد
الربان الإيطالى، مع الأمريكى السائح الأسود، بأن هذه سرقة وابتزاز و.. و..،
ويؤكد لى الأمريكى أن هذا مافهمه حين استبدل نقوده من أحد البنوك الرسمية، عند
وصوله فى أول الأمر، فهم أنه يستطيع استبدال ما يتبقى معه من نقود مصرية عند
مغادرته، مادام قد استبدلها بطريقة رسمية. ولعل هذا صحيح ـ لست أدرى ـ ولعل غموض
التعليمات هى التى أوحت له أن ذلك ممكن فى الباخرة، أو فى أى بلد بعد مغادرته.
ولعل عذراً ما معه، لكن ما أوقفنى وأثارنى ـ منذ البداية ـ هو هذا الاندفاع إلى
اتهامنا بكل هذه التهم، والتصديق عليها من أمريكى وإيطالى معا. وتصاعد الغيظ حتى
التدخل، ضد كل ما أوصيت نفسى به، وما نبّهتنى زوجتى إليه، وهو أن" أكون فى
حالى"، وألا أحاول تعديل أخلاق الخواجات كما اعتدت أن أمارس ذلك مع أبناء
بلدى، ولم تُذكّرنى كيف فشلتُ فى تعديل أخلاق المصريين، ناهيك عن أخلاقى أو
أخلاق أولادنا، أوصتْنى زوجتى بكل ذلك دون أن تقوله، فكم قالته، بلا طائل. بدليل
أننى تطوعت مقتحما وأنا أقول للأمريكى أن ثَـمَّ وقتا للعودة إلى البنك فى
الميناء، ومحاولة استيضاح ما غمُض عليه، فيذهب، وقد تعجبت لمبادرته بسماع
النصيحة. لكنه سرعان ما يعود ماطا شفتيه، فأرجح أنه استفسر من سلطة قريبة،
فأسأله بإلحاح مشفق حذر عمّا حدث، فيقول: لا فائدة، لقد "أكلتـُها".
وتتم القصّة فصولا، بأن يبدل له مساعد القبطان (الإيطالى) قيمة ما يحمل من نقود
مصرية، بأقل من قيمتها الرسمية بلا أوراق ولا يحزنون (تذكّر مرة أخرى أننا سنة
1984). وهكذا ينقلب الناصح الأمين تاجرا منتهزا، عينى عينك، وأقول لنفسى: لا لوم
عليه وحده، وإنما اللوم علينا أيضا وقبلا. قليل من الوضوح والتعليمات المكتوبة
منذ البداية ـ يحفظ السمعة. تلعب المصادفة دورها: إذ تجمعنى بهذا الأمريكى
الأسود على مائدة العشاء، فى السفينة، فأحاول ـ من جديد ـ أن أوضح له الأمر،
ولكنه ـ فى ثقة و غباء الأمريكى المتفوق!! ـ يؤكد أن هذه ليست إلا وسيلة
"رسمية" للحصول على أكبر قدر من العملة الصعبة، وأنه ـ فور وصوله ـ
سوف يبلغ سفارتنا ووزارة خارجيته بما حدث... وأنه... وأنه... وأرفضه بالقدر ذاته
الذى ألوم فيه المسئولين عندنا عن احتمال عدم الوضوح. كانت تلك هى
مقدّمة حوارى مع هذا الأمريكى ـ بهذه المواصفات ـ أثناء العشاء، حوارنا فى
السياسة والحياة. رحت أرسمه، وأنا أحاول طول الوقت أن أذكّر نفسى بالتحذير
المبدئى القائل: إن هذا الرجل الأمريكى ـ ليس بالضرورة الممثل الرسمى لمن هو
أمريكى. هو ليس أمريكا. هو رجل شديد
الثقة بما يقول، وخاصة إذا تحدث مع من يتصوره دونه (ويبدو أنه يعتقد أن كل من
بالسفينة هم كذلك). هو يتكلم وكأنه يُفتى. يصدر أحكاما نهائية من منصّة علوية
معصوبة العينين، وقد وجدتُنى رافضا لهذه الأحكام والفتاوى فى الكبيرة والصغيرة.
الحرية ـ كما أتصورها ـ هى مقرونة بالتواضع والحيرة المسئولة، فاستدرجتُه
ليحدثنى عن نفسه وبلده بعد أن حكيت له عن زيارتى الأخيرة لبوسطن ونيويورك
وواشنطن، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، فنبهنى أن هذا خطأ من يزور الولايات
المتحدة، فمن لم يزر ولاية واشنطن state فى أقصى الشمال (لا مدينة واشنطن العاصمة D.C.)، ومن لم يزر فلوريدا فى أقصى الجنوب، فهو لم يعرف الولايات
المتحدة. ولعله صادق، ولكنى بعد قليل تبينت أنه من فلوريدا، وكان يعمل ويقيم فى
ولاية واشنطن تلك، ورجّحت أن كل فرد من ولايةٍ "ما"، يعتبِـرُ نفسه
وولايته هما الممثل الشرعى لهذه القارة غير المتجانسة. وأمتلئ غيظا من هذا
التوحد الاحتكارى الغبى.
ويذكرنى هذا
بغيظى طفلا من واحدة لا أعرفها، لكننى أعرف أن اسمها "هانم"، أصرّ
شاعر مولد الشيخ الرخاوى (هو عم لى، غير شقيق، كان عالما أزهريا، لكن ابنه قلبه
بعد وفاته شيخا له مقام ومولد على طريقة متفرعة من الطريقة النقشبندية
الجوديـّة) أصر هذا شاعر المولد هذا أن "هانم" هذه هى الممثلة الشرعية
المعترف بها لما هو "امرأة"، وبالتالى فإن من ليس معه مال يمكـّنه أن
يتفرج على هانم سوف يموت "قتيل المحبة، والسبب هانم". كان يغنى: "قلبى عشق بنت بيضا واسمها هانـم، دقّه على
صدرها محمل بـِسـَالاَلــــِمْ واللى معاه
مال ييجى يتفرّج على هانم. واللى بلا
مال، يموت قتيل المحـــــبّة، والسبب هانم" ولما كان
مصروفى آنذاك ـ حتى أثناء المولد ـ لا يكفى لأتفرج على هانم هذه، فقد كنت أحقد
على الشاعر وعلى هانم حقداً بلا حدود؛ لأننى كنت على يقين أنى سأموت ـ قتيل
المحبة ـ دون أن ألمس امرأة؛ مادامت هانم هذه هى كل النساء. ولكننى رويدا رويدا
أكتشف أن الدنيا مليئة بعنايات وزينب وست الناس وفتحية وفوقية، ثم أُلفت ومرفت
ونُهى، ثم مارى وإليزابيث وديانا وصوفيا، وأتذكر كيف تحديتُ احتكارية هانم هذه
وأنا أشاهد تلك اللقطة من 30 يوم فى السجن، التى تفتح لمن مثلى كل الأبواب وهى
تؤكد أن كل النساء حلوات، وأن لكل واحدة مذاقها الخاص، "يا خى يوه يوه
يوه"،،. فكان الريحانى - ومن بعده عادل خيرى- فاتحها على مصراعيها، خيارة،
تفاحة، برتقالة، يا خِى يوه يوه يوه. وكلما شاهدتُ هذا المشهد فى المسرحية تمنيت
لو بـُعث شاعر مولد عمى الشيخ الرخاوى فى قريتنا من غيبته؛ ليشاهد هذا التطور
الخطير معى حتى يخجل مما أذلنّى به صغيرا. ثم يأتى هذا
الأمريكى الفلوريدى يقول لى إن الذى لم يتفرج على موطنه الأصلى، أو على مكان
عمله شخصيا لم ير أمريكا، فيغيظنى الغيظ ذاته الذى يعترينى كلما قابلت صاحب فكر
أو عقيدة، وقد احتكر الجنة لأهل دينه، واحتكر الصواب لمفردات عقيدته. واحتكر
الإخلاص لطين وطنه، ولكننى أهدىء نفسى حتى لا أستسلم للتمادى في الرفض؛ وأتذكر
كيف أقع فى نفس الخطأ بدورى حين تعلّ علىّّ مصريتى، فأبالغ فى عظمة وخطورة
الانتماء لها، هذا الانتماء الذى يغذى غرورنا ووجداننا حتى يجعل من مصر أم
الدنيا فى كل العصور؛ ربما لأن الذى بناها كان فى الأصل حلوانيا قبل أن يقول
مصطفى كامل قولته الشهيرة (بحسن نية ساذجة: إننى لو لم أولد مصريا..إلخ)، ويخطر
على بالى أنه إذا كان صحيحا أن "اللّى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى"،
فلا بد أن الذى بنى أمريكا كان فى الأصل "بتاع كشرى". ما زال هذا
الأمريكى يحكى لى عن نفسه: قال إنه لم يبلغ الخمسين، وإنه متقاعد من سنوات، وإنه
كان يعمل فى الجيش، وإنه أمضى خدمته فى السعودية (ولم أدر أين، ولماذا؟؟- كان
ذلك قبل حرب الخليج طبعا)، وإنه الآن "يسيح" فى العالم هو وزوجته بعد
أن استقل أولاده عنهما، فابنه البكر فى التاسعة والعشرين من عمره (!!!)، وبنتاه
مستقلتان من سنين. وتعجّبت، فاستوضحت، متى تزوج؟. وقد كنت أحسب أنى عملتُها مبكرا
مغامرا (72 سنة)، ولكنه أوضح لى كيف بدأ حياته الزوجية الكاملة وهو حول السابعة
عشر. ويبدو لى أنه بدأ مبكرا لينتهى مبكرا، وكأن هدف البداية كان هو هذه
النهاية، تصوّر أن يكون هدفك فى الدنيا هو "التقاعد اللذيذ"، أو حتى
"التقاعد السائح اللذيذ"!! يا صلاة النبى! هدف التقاعد المبكر أصبح من
معالم دورة حياة الرجل الأمريكى، حتى أننى تصورت أن شطارة الشخص هناك يمكن أن
تقاس بمدى نجاحه في التبكير بالتقاعد. ثم ماذا؟. لست أدرى. هذا الأمريكى الأسود
قال لى إنه يمضى بقية حياته فى السياحة، وآخرٌ يقضيها فى التأمل فى كوخ بالجبل،
وثالثٌ خلف سنارة صيد فى منتجع منعزل هادئ على شاطئ مجهول، وحسدتُه ابتداء، يا
ليت،!! ثم رفضتُه فورا، ما هذا؟، فتصوّرى دائما أن تفجــُّـر وسط العمر، وإبداع
الكهولة، هو النتاج الأبقى للبشرية. ومن غير المعقول، أن نربى أشجار البشر حتى
تتطاول فروعها وتطيب ثمارها، ثم نحيلها إلى التقاعد، مكتفين بالظل، وعينات مجففة
من طرحها القديم!!!. برنارد شو، وبرتراند راسل، ونجيب محفوظ، متى نضج عطاؤهم؟.
وماذا لو كانوا قد تقاعدوا فى سن هؤلاء المتحضرين الجدد؟ المهم، حسدته على الرغم
من كل هذا التنظير، وحسدته أكثر حين شاهدته بعدُ مع زوجته: امرأةٌ فتية نضرة شقراء دمثة، لا يفتأ فى رقّة
ـ غير سوداء ـ يميل عليها ليعدل من ياقة "بلوزتها"، أو يمـسح لها بعض
البقايا المتناثرة خطأ حول فمها، البقايا التى لا يراها أحد سواه، بقايا ماذا؟
لست أدرى. أنا مالى؟ ثم هو لا ينى يلثم أطراف أصابعها. متى تزوجتْ هذه السنيورة
التى تمّ نضجها فى هذه السن المتأخرة دون أى تراجع، متى تزوجتِ من هذا الرجل؟
ولماذا؟. ليس عجبى لمجرد أن شقراء تزوجت رجلا أسود، فهذا أمرٌ ألـِفْتُه فى
باريس ونيويورك وألف ليلة وغير ذلك، ولكن لأن هذا الرجل بالذات لم أجد فيه قوة
السود، افتقدتُ فيه نبض أرضى فى أفريقيا، لم أتصور فيه فحولة الفطرة وجاذبية
البداءة، وهى الصفات التى أتصورها تميز هذا الجنس الأصيل. أرجع إلى
الحوار معه، فأنكشه فى انتخابات الرئاسة (الأمريكية سنة 4891) فيُفتى ـ دون تردد
ـ أنها دائما أبدا لعبة محسوبة تُـولّى علينا من يقودنا دون فروق كثيرة بين
الكاسب والخسران، ويسألنى: هل تعرف مغزى "لعبة البدّال"؟. ولم أفهم
ماذا يعنى؟. قال "خدعة البدّال" تلك التى علمونا إياها صغارا؟ قلت له
إننى لا أعرف عن ماذا يحكى، فقال لى إن راكب الدراجة يضع قدمه فوق البدّال،
والبدال يرتفع، ولكن القدم دائما ترتفع أعلى منه، مهما ارتفع البّدال أو انخفض،
فقدمُ الراكب فوقه أبدا، هكذا السياسة، هم فوق، ونحن تحت، دائما، مهما حاولنا،
ومهما ارتفعنا، فأقدامهم فوق رؤوسنا بلا خلاص، يسرى ذلك علي البدال الأيمن كما
يسرى على البدّال الأيسر، جمهورى، ديمقراطى، نفس الحركة، ونفس النظام. أعجبت بفكرته،
وتراجعت عما ظلمته به من أحكام، ثم غمرنى يأس حين تجسّدتْ لى اللعبة المقابلة فى
بلدنا، نحن لم نصل بعد إلى خدعة الحركة الزائفة (لعبة البدال) نحن نلعب مع
السُّلطة (بكل أنواعها) لعبة "وابور الزلط"، كنا فى طنطا،
وكنت حول السادسة من عمرى، كانت الحرب العالمية الثانية، صفارات إنذار التجارب،
تطن فى أذنى. كانوا يرصفون بعض الشوراع حديثا. حين كنت أشاهد العجلة الأمامية
الضخمة لوابور الزلط وهى تزحف "تبطط " كل شىء. أُرعب من أنها يمكن أن
"تبططنى" شخصيا ضمن ما تسحق، مع أن خطواتى القصيرة الصغيرة كانت أسرع
من حركة الوابور دائما، بل إننى كنت أتّصوّر أن وابور الزلط هذا يسير وحده دون
سائقه الذى كانت ملابسه بلون الزفت الذى يسير فوقه، فكان من السهل أن يخفيه
خيالى، فإذا فَرَضَ هذا السائق نفسه بصيحة تحذير مثلا، كنت لا أملك إلا الاعتراف
به، ولكن باعتباره تابعا مقودا من الوابور لا سائقا أو قائدا له. ذلك أننى كنت
أشعر أن وابور الزلط هذا كائن حى يمكن أن يتذكرّنى شخصيا، وأن يعدّ خطة سحقى،
ولم أجرؤ، وإن كان قد خطر ببالى، أن أرشوه (الوابور لا السائق)
بـ"ساندوتش" الصباح، فلا هو سوف يشبعه، ولا حشوه يستأهل. قلت فى نفسى:
إذا كان تبادل السلطة عند هذا الأمريكى المتغطرس تمثل لعبة البدّال، الحاكم فوق
والناس تحت، دائما أبدا، مرة يمينا ومّرة يسارا، فهذا أمرٌ طيب، هى حركة والسلام،
أما عندنا فالسلطة مثل وابور الزلط، ونحن: أطفال فى السادسة.، نخاف أن يبططونا
دون ذنب. أوقفـْتُ
خيالى قسراً. أنا مسافر لأستريح، لا لأجتر الهم، لعبة البدال عندهم، ولعبة وابور
الزلط عندنا، ماشى، هذه مجرد اختلافات ثقافية يا عزيزى!!!
ما هذا الذى
أبدأ به رحلتى هذه؟!!، فاقتحمتُ سخريته ويأسى بخبطة واحدة سائلا: إذن ماذا؟. إذا
كانت المسألة دائما واحدة على الجانبين، مع اختلاف الأحزاب والمرشحين والرؤساء،
إذن ما العمل؟. ويتعجب لسؤالى، ويرفع حاجبيه، ويمـط شفتيه، معلنا أنه
"....وأنا مالى؟" (هو ماله!!!)، فأشعر باطمئنان كاذب لتوارد الخواطر،
وكأنى به يقول: لم يعد لنا فى الأمر شىء، وتقاعدى ليس تقاعدا عن عملى فقط، ولكنه
تقاعد عن مسئوليتى تجاه ما يحدث، مما ليس لى فيه يد، ولا رأى، رغم أوهام
الديمقراطية، وتكرار الانتخابات. ومع ترجمتى هذه للسان حاله، أصررت على مواصلة
الحوار، وأصرّ هو على أنه لا حل، ومع ذلك ـ ولعجبى الذى يتجدد بلا أدنى مبرر،
لأننى على علم مسبق طول الوقت بشيوع هذا الموقف المريح ـ بدا لى جليسى مطمئن
البال، قرير العين لهذا "اللا حل". ولم أحاول أن أستمع أكثر من ذلك،
فقد تعلّمت أنَّ هؤلاء الناس استقرّوا "بشكل ما"، على "شىء
ما"، هم لا يدرونه فى الأغلب. فقد رُسِــم لهم بدقة بالغة، من نظام شديد
الإحكام (بدأ غربيا وانتهى عالما والعياذ بالله). هو نظام شديد التعقيد
أيضا. لا أظن أن أحدا يعلم من
الذى يديره (كان هذا الظن قبل شيوع تعبير "النظام العالمى الجديد الذى لوّح
بما زاد الأمر غموضا). من أهم أهداف هذا النظام ـ على ما أظن ـ هو العمل على تحييد رجل الشارع، تحييد الناس، كل
الناس، بقية الناس، (اللهم إلا أثناء الانتخابات بما لها وما عليها) يبقى بهذا الشكل الأمر، أى أمر، مع من
بيده الأمر، الذى هو بدوره يقع فى يد أعلى هى التى تدبـر "الأمر"،
فيصاب الشخص العادى بمرض "الحكمة المُعدى"، يحمى نفسه من مسئولية
التساؤل. من أهم مظاهر هذا الهرب أن يظل الواحد متفرجا طول الوقت بلا فاعلية، ولكن بانتباه شديد. هو
يتفرّج حتى وهو يدلى بصوته بين الحين والحين، لكن لا خوف منه، ولا من صوته، ما
دام من بيده الأمر (لا من يهمه الأمر) يلوّح له بشعار الديمقراطية وحقوق الإنسان
طول الوقت. إيقاع لعبة
السلطة فاق بكثير قدرة الشخص العادى على متابعة الأحداث، فضلا عن الإسهام فى صنع
القرار. ومع ذلك لم أستطع أن أمنح نفسى حق مثل هذا الانسحاب الحكيم. أتصور من فورى ـ وبطريقة خاطئة حتما ـ
أننى "شخصيا" مسئول عن تعديل كل ذلك، وكلما كان الأمر واقعا أكثر،
كانت مسئوليتى (الإبداعية!!) أعمق وأخطر (ما هى حكاية الإبداعية هذه؟). أقول
لنفسى مخادعا فى الأغلب: إذا كنت لا أملك بديلا واضحا، فلا أقل من أن أعيش خبرتى
مهما طالت وآلـَـمَت، لعلها تولّد قلقا خلاّقا. أما أن أقف ساخرا راضيا عالِــما
حكيما متفرِّجا، فهذا ما لم أنجح فيه حتّى تاريخه. كنت، ومازلت، أحسب ذلك
التظاهر بالرضا والتسليم، أو "الأناماليّة" رفاهية، لا حقَّ لى فيها. أواصل الحديث
مع الأمريكى الأسود ناسيا ما نبهـّت نفسى إليه حالا، فأنكشه ـ مرة أخرى ـ موجها
الحديث إلى دور القس جاكسون (لاحظ التاريخ)، مرشح الرياسة السابق الذى فشل فى
تعضيد حزبه له، وكان فشله معروفا مسبقا، ولكن مجرد محاولته كان لها دور ـ
بالنسبة لى على الأقل ـ فعندى أنه أدى دورا، وقال كلمة. فيتحمس جليسى بغير روح،
ويقول إن جاكسون هذا كان سيفعل شيئا آخر، ولكنه لا يقول لى ـ ولا لنفسه، ربما ـ
كيف كان سيواجه الحاكم السرى الحقيقى لبلده العملاق، الغافل عن مصيره/ مصيرنا. أشعر فى نهاية
الحوار أننى أمام "أمريكى فقط"، و ليس إنسانا أسود حطّ أجداده ظلما وخطفا فى هذه الأمريكا، إنه لا يعلن بسواده
رائحة الطين، وقوّة الأبنوس، وشموخ الـليل، كما يعنى لى كل ما هو أسود. هذا
"البنى آدم" الذى هو أمامى هكذا: لا هو بالثائر الواعى الذى يتعصّب
لـلونه ـ ولو مرحليّا ـ، ولا هو بالمنسحب الفنان المبدع الذى يرى رؤية مستقبلية؛
ليساهم فى إظهارها مهما صغـُـر دوره. هو مجرد أمريكى، تصادف أنّه أسود، فتزوّج
من بيضاء جميلة، فرضىَ بهذه النقلة "السرية" إلى الجنس الأرقى، أعنى
الجنسيّـة الأرقى (!!)، فماتت قضيته قبل أن تبدأ. قبل أن أغادر
مطعم الباخرة الذى كنت أجالس فيه هذا المتقاعد الأسمر (بهـُتَ سوادُه!!)، يحدث
فصل بارد إذ يتقدّم النادل منى بالحساب، فأُخرج له "كوبون" العشاء
الذى صرفوه لنا مع التذاكر، فيبتسم فى استعلاء مهذب، وأن هذا الكوبون خاص بمطعم
"إخدم نفسك على الواقف". أما هذا المطعم، فهو اختيارى، وبمقابل.
فأحاول أن أمنع حبّات العرق من أن تظهر أمام جليسى الذى تصوّرت أنه لا يـُخفى
امتعاضه منى، وأدفع بالتى هى ألْــسَـع، وأقول لنفسى: ولو. نحن أبناء الأصول
قبلا ودائما، والذى لا يعرفك يجهلك. وأبلعُ ريقى، بعد أن كتمت عرقى، وأمضى
ليتجمع سخطى على الأمريكى، أكثر من تجمعه تجاه النادل، أو تجاه النظام العالمى
القديم، (لم يكونوا قد جدّدوه بعد ليبدوا جديدا)، أو تجاه خيبتى وقلة خبرتى.
ثم أهدّئ نفسى
بحكمة متأخرة مكررة معا، فأقرص أذنها محذرا مجددا من التعميم. هذا الرجل ليس هو
أمريكا، وهذا النادل، ليس إيطاليا، وأنا لست مصر؟. 22 أغسطس 1984: أمضى يوما
واحدا وليلتين فى هذا المجتمع الصغير المتحرك، وألتقى بندرة من المصريين، فهم
يركبون البحر عادة فى رحلة العودة بالعربة والأشياء، وليس فى رحلة الذهاب هذه.
أعتبر أنه من مزايا السفر الحر بعيداً عن المجموعات، أن تتاح لك الفرصة أكثر
فأكثر للقاء من "ليس كذلك "، ولعل هذا ما نفّرنى منذ بدأتُ أفكر فى
ضرورة اتساع دائرة رؤيتى للعالم فى السنوات الأخيرة، أقول هذا هو ما نفرّنى
(ربما مؤقتا، وربما خطأ) من الرحلات الجماعية التى تنظمها شركات السياحة عندنا.
كنت أخشى ـ ومازلت ـ ألا تعدو هذه الرحلات الجماعية أو الفئوية المنظمة أن تكون
انتقالا فى المكان فحسب، فتمضى الرحلة بين المصريين فى عمليات تنافس الشراء،
وهمز المقارنات، وحذق التوفير، ومباهاة التسوّق، وأساليب الشطارة، بلا أدنى فرصة
لأن أنفصل عنهم، أو أن ينفصلوا عنى. فما جدوى الانتقال؟. وأين هو أصلا؟. هذا
فضلا عما سيفرضونه علىّ من أسئلة وشكاوى باعتبارى طبيبا نفسيا، ولا مؤاخذة. أقول: فرحتُ
بقلة المصريين، وكثرة الأغْراب، وتقمصت بحّارة السفينة وربانها، فعلمت معنى أن
تكون بحّارا، وأن تظل الأرض التى تعيش عليها تتأرجح فوق الماء طوال حياتك،
فيتأرجح معها وجودك، ويصبح انتماؤك إلى العالم أرحب، و أكثر مرونة من ذلك المقيم
فوق الرمال، أو أعلى الجبل، أوفى شقة بإيجار قديم وسط المدينة. ذات يوم لاحق
أخذت صديقتىّ هدى ونهى (7 و8 سنوات، وهما شقيقتا "أحمد رفعت" أحد
أصحابى فى هذه الرحلة) إلى حديقة الأورمان، كان يوم جمعة من أيام شتاء قاهرى جاد، كنا قد فشلنا أن نؤجر قاربا فى النيل لأسباب
طقسية، جلسنا على أرض الحديقة ورحنا نلعب. سألتهما الواحدة تلو الأخرى عن ماذا
تريد أن تكون حين تكبر، فأجابت إحداهما (لا أذكر من منهما تحديدا) أريد أن أكون
مدرسة وممرضة، وتعجّبت، وأعدت عليها الاختيار لتحدد أى المهنتين تفضل عن الأخرى،
فأجابت نفس الإجابة بإصرار، وأنها تريد الاثنتين معا. قلت لنفسى، ولمَ لا؟
وأصرّتا أن أشارك فى اللعبة، وحين جاء دورى (كنت قد تخطيت الخامسة والخمسين على
ما أذكر) سألتنى هدى عن المهنة التى أريد أن أكونها (!!)، ولم تذكر، أو تتذكر،
أو تُـشِر إلى أنى اخترتُ والذى كان قد كان، نظرتْ إلىّ هدى تنتظر الردّ، فعرفت
أنها تعنى سؤالها فعلا، وأنها لا تمزح، وأنها تنتظر جوابا، وأنها لا تقصد أن
أجيب بأثر رجعى (لو خيّرت كنت اخترتُ كذا أو كذا). رجّحت أنها سمحت لخيالها أن
يلغى الواقع ومعه تاريخى وسنى، فحذوتُ حذوها، واخترت مهنتين معا، وقلت لها أحب
أن "أطلع فلاحا وبحّارا"، وصدّقتـَنْى بنفس السهولة التى اختارت بها
لنفسها مهنتين معا. لعلى حين
أجبتها حينذاك كنت أعيش بعض آثار خبرتى التى أحكيها الآن عن علاقتى بالبحر
وتقمصى البحارة. تنبّهت من إجابتى تلك إلى علاقتى بالأرض وتقمّصى لفلاح بلدنا،
ومشاركتى له بعض أيام طفولتى فى جنى القطن، أو "دراس" القمح، ومايرتبط
بهذا وذاك من معنى الغوص فى طين الأرض والاستقرار، فى مقابل حركة البحّار وهـو
يجوب العالم، أرضه سفينته، وغايته الدنيا بأسرها، ووجدت نفسى هذا وذاك معا دون
صراع، ألستَ معى أنهما يتكاملان؟ بدأت بصيرتى
تتضح فيما يتعلق بعلاقة نوع وجودى بما سوف يأتى فيما بعد بشأن "حتم
الحركة" و"برنامج الذهاب والعودة" المتكرر بلا انقطاع، يبدأمن
طين الأرض وجذورى ثابتة ممتدة ليظل يتمايل مع حركة البحر المترجحة بلا شطآن عبر
أفق ممتد. أعيش رقص
الباخرة، وإيقاعها الهادئ، وتعليمات مساعد الربان المتوالية، والدعوة تلو الدعوة
لتناول الوجبات، وهو يتمنى لنا "شهية طيبة"، ويدعونا للمشاركة فى
ديسكو المساء، أو يدعو الكاثوليكيين فقط لقدَّاس الصباح!!، لا أتعرّف على
أحد خلال يوم واحد، ولكننى أخرج مؤكدا لفكرتى القديمة التى ذكرتها فى مقدمة هذا
الحديث من أن الطائرات على عظم ما أضافت واختصرت، قد حرمتنا من فرص أروع، وإيقاع
أهدأ.
أخرج بين
الحين والحين إلى سطح السفينة، لأجد البحر العظيم، أصل الأشياء، وقد احتوانى من
كل جانب. أفتح وعيى للانهائى، فأتلاشى بإرادة أعمق، وتتضاءل الأفكار والطموحات،
وينطفئ الغرور، ويرفرف الشك - دون رفض - على كل ما فات.
ولـِمَ
لا؟ وإلا، فما جدوى السفر ؟ مساء 22 أغسطس
1984: تصل الباخرة
إلى ميناء بيريه، وهو جزء لا يتجزأ من أثينا العاصمة، وإن كان الفصل بين ما هو
بيرياس (هكذ ينطقونها)، وماهو أثينا، فى الحديث والروح والأسعار والإجراءات، هو
فصل شديد الوضوح منذ البداية. كنت قد واعدت أولادى ـ وقد وصلوا قبلى بساعات
بالطائرة ـ بلقاء فى ميدان عام فى أثينا، خشية ألا يعرفوا طريقهم ليلا إلى
الميناء. هذه أول مرّة لى ولهم، نحط الرحال هناك. وما كان اتفاقنا إلا فوق خرائط
لا تمثل لوعينا شيئا يمكن أن يُعتمد عليه، وهكذا لم أكن أتوقع أن يكونوا فى
الميناء فى انتظارنا، لكن هاهم أولاء هناك، هم فعلا!! يا خبر! ما الذى أتى بهم
هكذا "برافو"، أفرح برؤيتهم وكأنى لم ألتق بهم من سنوات، وكأنى قد
اشتقت إليهم دهرا، وكأنهم لم يوصّلونى إلى ميناء الإسكندرية صباح أمس. وأنا الذى
تمضى الأسابيع تلو الأسابيع فى القاهرة لا أراهم، ولا أسعى ـ قصدا ـ لرؤيتهم،
ليس فقط لاعتكافى المتصل ـ بعد العمل الضرورى ـ فى استراحة ريفية خاصة بجوار
القاهرة، وإنما حتّى وأنا أقيم معهم فى الشقة ذاتها، أراهم ولا أراهم، وأعجب
لتدخّل الحركة ـ بالسفر ومافيه وما يمثله ـ فى الإحساس بالزمن، وبالتالى فى
تلوين المشاعر، وتحريك الوجدان، وألمح فى صحبتهم سيّدة سوريّة تحتضنهم كأم رؤوم،
فأهتف فى سرّى غصباً عنّى: "تحيا الوحدة العربية"، ويعرّفونى بها،
وأنها أم أحد أصحاب الفندق الذى نزلوا به فى جليفادا، وأنها تفضّلت مشكورة
باصطحابهم إلى الميناء بما ترتب عليه من فرحة ذكرتُها. وأخجل من نفسى ومن أفكارى
العنيدة فى رفض هذا التقديس الذى أعتبره دائما مفتعلا لما هو "وحدة
عربية". لكننى لا أستسلم لتغيير مفاجئ، فقط أنبه نفسى أنّ علىّ أن أضع معنى
هذا اللقاء مع عربى فى الخارج، ومعنى فضل هذه السيدة على أولادى لمجرد أننا عرب
معا. أهمس لنفسى: ضع كل هذا فى اعتبارك مستقبلا وأنت تحكم وتشجب وتتشنّج. حاضر. تنطلق حافلتنا
بأرقامها المصرية تتهادى فى ليل أثينا المنعش. يقول لى بعض أولادى فى تأكيد
مندهش إنهم اكتشفوا أن أثينا هى - أيضا - أوروبا، وكأنهم اكتشفوا حقيقة جغرافية
جديدة، فأضحك وأقول لهم: فماذا كنتم تحسبون؟. فيفهمون ما أعنى. وتذهب ابنتى
لتؤكد أنها كانت تحسبها "قذرة" "زحمة"، مثلما الحال عندنا،
فأنبهـها بحدّة إلى عيب ما تقول، فتعتذرـ فى ألم واضح ـ لتعدل كلامها بما تقصد
أصلا، ويشترك معها بقيّة الأولاد فى شرح وجهة نظرهم: إنهم كانوا يسمعون كثيرا أن
اليونان هى مصر وبالعكس، وأن اليونانيين كانوا بمصر كثرة عاملة مهاجرة، ثم أصبح
المصريون باليونان، وخاصة أثينا، هم الكثرة المهاجرة العاملة، حتى أن اللغة
الثانية فى أثينا وبيريه هى العربية (هذا صحيح). فغلب على خاطرهم أنهم لن يجدوا
فرقا يذكر بين الشارع المصرى ودرجة نظافته وازدحامه، وانضباطه الشكلى قسرا لبضعة
أيام، بعد كل تغيير وزارة، أو تجديد وزير داخلية، ثم أبوك عند أخوك،
وبين الشارع اليونانى فى أثينا، فإذا بهم ـ خاصّة وقد نزلوا فى ضاحية
جنوبية لأثينا، شديدة الجمال، قليلة الناس، طاغية الخضرة، تسمى جليفاداـ فإذا
بهم يجدونها أقرب إلى ما سبق لهم رؤيته فى أوربا الغربية جدا، وعلى حد قولهم لا
تقل عن جنيف جمالا أو نظافة. ولم أعرف كيف أرد عليهم وأنا أقود السيارة وأنا لا
أعرف شيئاً مما يقولون. لم يسبق لى أن
زرت أثينا إلا لبضع ساعات أثناء رسو المركب فى رحلة العودة من فرنسا سنة 9691،
شاهدت فيها المقرر السياحى (الأكروبول) مشاهدة الدورة الروتينية السياحية
الفارغة، فانتظرتُ مؤجِّلا الرد عليهم حتى أستوعب كلامهم بهدوء حين أشاهد
مايحكون عنه صباح اليوم التالى. وقد كنت أحسب أننا سنسافر فجر هذا اليوم التالى،
إلا أنه بناء على هذه الصدمة الجمالية الحضارية، استجبتُ لرجائهم أن نمضى يوما آخر
ـ على الأقل ـ فى هذا البلد الجميل. فى الفندق،
وجدتُ الحديث بالعربية أساسا، ولم أرتحْ رغم فرحة داخلية، وفخر خفى. راحت السيدة (الأم) السورية السالفة الذكر
ترحب بنا بالطريقة العربية، فكادت تحرمنى من الشعور بالنقلة اللازمة للإعلان
الداخلى لبداية الرحلة. فهمت من حديثها، ومن الحديث معها، ومما وصلنى من بعض
المعاملات حولى، أن ثمة بداية هجمة تجارية استثمارية سورية على اليونان، هذه
الهجمة تبدو من الوفرة والنجاح بحيث تكاد تضارع الهجمة اللبنانية على
"نيس" و"كان"، وتصورت أن ثراة السوريين، ورجال الأعمال
الطموحين قد تحايلوا على النظام الاقتصادى هناك، بمد نشاطهم أو تحويل نقودهم إلى
الخارج، وما إلى ذلك مما سبق أن خبرناه فى مصر ونعرف عنه. ألمحت للسيدة السورية
بسؤال عن سببب إقامتها هنا، فوجدت منها عزوفا عن الدخول فى التفاصيل، بل إنها
أفهمتنى بإصرار لا مبرر له، أن ابنها ليس شريكا فى الفندق كما سمعتُ، وأنه يدرس
الهندسة، وأنها تقيم فى الفندق ـ بصفة مؤقتة ـ فى فصل الصيف. تظاهرتُ بتصديق كل
كلامها مــرغما، وحين سألتها عن الأحوال فى سوريا، ردّت ردّا اشتراكيا تقليديا
بأنها "عال العال"، فحوّلت الحديث بسرعة، ورضيت بهذا القدر من التصريحات
المحدودة. إلا أننى بعد أن التقيت بعدد من السوريين مصادفة، وبعد أن لاحظت عددا
من المطاعم الشامية الفاخرة، وبعد أن كنت أسأل أحد كبار السن من اليونانيين عن
اسم شارع أو رقم أتوبيس، فيسارع بسؤالى بالعربية إن كنتُ قادما من سوريا، بعد كل
ذلك تأكد عندى أن اليونان قد أصبحت "لهؤلاء "السوريين متنفسا طبيعيا
لحركة اقتصادية وهجرة مؤقتة. فرحت بحركة المد والجزر هذه. أعنى بها التبادل
الشرعى بين البلاد بالهجرة. و فرحت بقدرة إنسان العصر ـ ما أمكن ذلك ـ على تخطى
الحدود، ومحاولة التأقلم السريع لمتغيرات السياسة والاقتصاد حسب نظرته وطموحاته.
ولكننى أمِلت أكثر لو كان دافع الهجرة الاقتصادى يواكب دافعا آخر لهجرة حضارية،
مع الالتزام بالانتماء إلى الأرض الأم، أو مع استمرار رحلات "المكوك
"الواعية والمنتظمة، وبدأت أراجع نقدى المستمر والقاسى لما هو حضارة غربية،
والذى لم أتراجع عنه أبدا، ولكننى فتحت بابا جانبيا لإعادة النظر. أنا لست أدرى ماذا يعنى تعبير "الجوع
الحضاري"، إن وُجِدَ أصلا، لكنه خطر ببالى هكذا، كما خطر ببالى ـ أيضا ـ
تعبير آخر هو "الاختناق الحضارى" ثم "الفقر الحضارى"، ورجحت
أننى وقعت فى لعبة الكلمات المتقاطعة التى تقتحم ذهنى بين الحين والحين، على
الرغم من أنى لا أعرف اللعبة الحقيقية المعروفة بهذا الإسم، ولا أحبها ولم
أحاولها فى حياتى، فــرُحت أحاول أن أكوّن جملة مفيدة مما يقفز إلى وعىى هكذا
دون سابق ترتيب، فأقول: يا حبّذا لو
كان الدافع إلى السفر ـ فالهجرة عند بعضنا ـ نوعاً من علاج مرض "الاختناق
اللاحضارى" أو الفقر الحضارى؛ سعيا إلى إشباع "الجوع الحضاري"،
جنبا إلى جنب مع أكل العيش والتهريب. لا تقنعنى هذه
الجملة بما كنت أرجو، إذ تبدو لى وكأنها حكمة هروبية خليقة أن تحرمنى من طلاقة
الشطح وبراءة الاستكشاف، فأُصدر فرمانا أن أكف قسرا عن مواصلة هذا الحديث
الداخلى المُلَـفْظَـن؛ لأقـترب أكثر مما يدور حولى. 23 أغسطس 1984: انتقلنا فى
الصباح إلى أثينا دون سيارة؛نظرا لاتفاقنا أن يكون المشى داخل المدن هو وسيلة
الانتقال (الأُولى). كان الأولاد هم المرشد لنا لسبقهم لنا بساعات أتاحت لهم
استعمال الأتوبيس العام ومعرفة بعض أسماء الأماكن والشوارع، وكان عجبهم أن
الراكب يضع أمام السائق ـ فى صندوق بجواره ـ بعض الفكة مما يعرف أنه تعريفة
الركوب. بلا تذاكر ولاكمسارى ولا يحزنون، فمن أين للسائق أن يعرف أن ما وضع
و"شخشخ"، هو المبلغ المضبوط؟. لابد من افتراض درجة من الأمانة. لابد
أن هؤلاء الركاب ـ أو أغلبهم ـ أمناء. هذه حقيقة أخرى، وصدمة أخرى ذكّرتنا
ببدهيات تقول: "إن الأصل فى المعاملات الأمانة، لا الشطارة (ولا الحداقة)،
والأصل فى الحق أن يصل إلى صاحبه، وليس أنه "اللى ييجى منه أحسن منه".
وقد تدهورت عندنا القيم العامة، والانتماء إلى الدولة الواحدة، والحق المجرد،
لدرجة بات معها كل واحد منا (أو كل أسرة أو كل فئة) دولة قائمة بذاتها، وأصبح
التعامل بيننا لا يربطه قاسم مشترك، لا حق الله، ولا حق الناس، و لا حتى، حق
النفس. لعل هذه المقارنة هى ما بهرت الأولاد وهم يكتشفون أن جليفادا وأثينا هما
فى أوربا وليستا مثل مصر. بالقرب من
"سينتاجما" (مجلس الشعب تبعهم !! على الأرجح)، وجدنا الحَمام والتاريخ
فى انتظارنا كالعادة. أصبح منظر
الحمام، وهو يلتقط الحب وفتات الخبز من أيدى السائحين، منظرا مُقَررا فى كثير من
بلدان العالم. أنت تجده هنا كما
تجده فى ميدان سان ماركو بفينسيا، وأمام الساكركير فى باريس، والكنيسة الكبرى فى
ميلانو وحول الكعبة المقدّسة. تقفز إلى وعيى أن فكرة الأشـُهر الحرم، ومنع الصيد
فى أماكن بذاتها، وأوقات بذاتها، هى فكرة كامنة فى وجدان التكوين البشرى يصالح
من خلالها إخوانه الأحياء، الذين استحل قتلهم بلا مبرر فى غير هذه الأماكن، فى
غير هذه الأيام. أما منظر الجنديين ذوى الزى التاريخى، والخطوة البطيئة
المرتفعة، وهم يقومون بدورهم، كديكور بشرى لـلفرجة والتذكـِرة، فهو منظر يبدو
جميلا ـ لأول وهلة ـ بلا أدنى شك. وهو يتكرر فى المنشية عندنا بالإسكندرية، كما
يتكرر أمام قصرالملكة فى لندن، وغير ذلك كثير من بلاد الله، لكن المعنى فى
استعمال كائن بشرى حى للفرجة عليه، هو معنى يقلقنى كثيرا، حتى المهرج فى السيرك،
وهو يقوم بدوره للفرجة، له عندى قبول أكثر من دور هذا "الجندى
الديكور". يقترب
السائحون من الجندى الواقف "زنهار" قبل معاودة سيره، ويلمسونه برقّة،
فلا يتحرّك. هم يلتقطون الصور بجواره وتحت قدميه، ثم يعاود الجندى سيره
واستعراضه. أتصوّر ،لأهدّئ نفسى، أن الجندى راضٍ بما يفعل، وأنه يكافأ مكافأة
كبيرة لأدائه هذا الدور هكذا، وأنه لا يستمر هكذا ساعات طويلة؛ إذ لا بد أنه
يُستبدل قبل الإنهاك، ولا بد أنه فخور وهو يتقمص تاريخ بلده، فخور بما يفخر به
بنو وطنه، لكن كل ذلك لا يمنع الغصّة التى وقفت فى حلقى، وتسحبت منه حتى غمرت
بدنى، فتكوّمتْ لتصبح قبضة تضغط على قلبى. حاولت أن أقــلد مشيته لأتقمّص شعوره،
أبدا، قلت: الإنسان ليس ديكورا متحركا، وما عاد ينبغى أن يكون كذلك مهما كان
الثمن والمعنى والرمز. وهل نحن - من
عمق معيّن - غير ذلك ؟ إخرس يا جدع أنت هل هذا وقته؟ افترقنا:
أولادى وزوجتى فى مجموعة، وأنا وحدى (فى مجموعة!!!)، على أن نلتقى ظهرا. فعلت
ذلك كى أعفيهم من وجودى المرهِق الثقيل عليهم غالبا (أنا الذى أدّعى ذلك دون
يقين) ولأعفى نفسى من التطلع بلا نهاية فى واجهات المحلات بشبق غامض. كنت قد وضعت
لأفراد الرحلة نظاما نقديا؛ بحيث يحمل كل فرد مبلغا محدودا يتصرف فيه باستقلال،
يأكل على حساب راحة النوم، أو ينام نومة أفضل على حساب ما يشترى، أو يشترى على
حساب النوم والأكل..إلخ. هو حر...يتصرّف فى حدود المبلغ الذى تسلمه فى بداية
الرحلة، وحتى نهايتها.(أظن كان المبلغ خمسمائة دولارا للفرد طول المدة ـ 82 يوما
ـ، وكانت قيمة الدولار فى السوق السوداء آنذاك 47 قرشا صاغا!!) ذلك أنه كان من ضمن أهداف الرحلة أن
تكون رحلة كشفية معسكرية مخيمية أساسا، لا سياحية ولا استهلاكية. معنا الخيمتان
والمواقد والأغطية وأحذية المشى والنقود المحدودة، وما قـــُــدّر يكون!!. تركتهم، وتركت
قدمىّ تقودانى كما عوّدتهما فى الأماكن الجديدة، واتفقنا على اللقاء بجوار
الـ"سينتاجما" بعد ثلاث ساعات. تبعت قدمىّ البصيرتين ورحت أتجوّل
كعادتى حولى وداخلى دون ترجيح أى كفة، فأجد عدد الناس أقل، وعدد الخدمات أكثر،
وعدد الأصوات الزاعقة أقل، وعدد الزهور والخضرة فى الشارع والشرفات أكثر، وعدد
العربات أكثر، وحجمها أصغر، وعدد الشوارع وسعتها أقل، وأكثر (المقارنة بما عندنا
طبعا آنذاك). أذهب لأبحث
أولا عن خرائط للطرق التى سوف أقطعها عبرأوربا، فهذه أول مرّة أبدأ جولتى من
الجنوب. اعتدت أن أتسلح بالخريطة والبوصلة بمجرد أن أضع نفسى فى سيارة الترحال،
حتى حذقت اللعبة، ويقابلنى مكتب يوجوسلافيا بترحيب جيد، يذكرنى بأنها البلد
الوحيد التى منحتنا تأشيرة دخول بلا مقابل (كانت أيامها يوغسلافيا بحق وحقيق).
ولا أظن أن هذا فقط من باب تشجيع السياحة والدعاية، وإنما أعتقد أنه مبدأ أساسى
من مبادئ الفكر الاشتراكى، وأحصل على ما أريد من خرائط بعد جهد متوسط لصعوبة
التعبير، وأفرح بحاجز اللغة على الرغم من أنه شديد، فما أحوجنا أحيانا إلى
الحديث بالوجه والإشارة باليدين، بعد أن أغارت الكلمات القديمة الجوفاء على عمق
نبض وجودنا. أُفرغت كثير من ألفاظ الود والتواصل من وظيفتها. أفـرح حين أجد الحروف اليونانية ذات الرسم اللاتينى
الواحد تُنطق بطريقة أخرى. أنت حين تَقرأ كلمة يونانية وكأنها إنجليزية أو
فرنسية، سوف تـَـنطِقُ كلمة أخرى تماما. أدركت ذلك وأنا أقارن بين أسماء البلاد
خلال الرحلة وهى مكتوبة باللغتين اليونانية والإنجليزية (أو ما شابه) فأجد حروفا
غريبة علىّ، والأهم أنى أجد حروفا واحدة لها ذات الرسم إلا أن نطقها مختلف
تماما، أتذكر صديقا
لى كان فى باريس، سوف يأتى ذكره مرارا فى الأغلب، كان نصفه إيطالىاً، ونصفه
فرنسىاً. ضبطنى مرة، وأنا أكتب بالعربية، فوقف ينظر من خلف كتفى إلى الكتابة من
اليمين إلى اليسار، وهى غير منتظمة فى أىة نمطيّة يعرفها هو، فأخذ يتطلع إلى ما
أفعل والنقط تتراقص فى حرّية فوق بعض الحروف دون غيرها. وقف ينظر وكأنى فنان
تشكيلى أقوم برسم لوحة ليس كمثلها شىء، وحين لاحظ أنى رأيت كل هذه الدهشة على وجهه
صرّح لى بما يدور فى خلده، وأن فروق الكتابة ليست أقل دلالة على روعة اختلاف
البشر من فروق الكلام الصوتى، ثم طلب منى أن أكتب له اسمه بالعربية، ففعلت، فأخذ
يتأمله، ويقربه ويبعده، وهو فى دهشة غير مصدق، قائلا بالفرنسية ذات اللكنة
الإيطالية إنه "غير معقول". ويضحك، ثم ينظر ويضحك، ثم يضحك وهو ينظر،
ثم يضحك فقط حتى اضطررت أن أشاركه فى طفولة رائقة فرضتها علينا دهشته البريئة،
وحين ذهبنا للغذاء مع زوجته، أخرج من جيبه هذا اللغز المصوّر (اسمه مكتوبا
بالعربية) وأراه لزوجته، وراح يضحك من جديد، حتّى أضحكنا من جديد. تذكّرت ذلك مع
الفارق، وأنا أشاهد لعب الحروف الجديدة ليس فقط برسمها، ولكن بنبراتها ورنينها
أيضا، وتحرّك وعيى أرحب. تقودنى قدماى
إلى الأكروبول دون سؤال أو قصد محدد، فأتوجّه إليه منفردا ومجذوبا تلقائيا، وليس
جزءاً من معالم سياحية مقررة مثل زيارتى السابقة الخاطفة له، أختار إليه ـ
كالعادة ـ أضيق الشوارع وأقدمها. منذ إقامتى
قرب المونمارتر فى باريس ذلك العام (86 ـ 96)، وقبل ذلك منذ تعوّدى على الوصول
إلى منزلنا فى قريتى من محطة قطرالدلتا مخترقا "درب الوسط"
"(الملتوى كالثعبان، الضيق كنفق سرى) متجنبا داير الناحية، منذ هذا
وذاك، أتصوّر أن تاريخ البيوت بدأ
متقاربا فى مواجهة حميمة، وأن الشوارع قد ظهرت بينها فيما بعد، لتصبح ممرات
قسرية شُقت للضرورة، وما أصبحت الشوارع ميادين، ولا حلقات سباق، إلا حديثا. لذلك
فإننى أهتدى بحدسى وخبرتى أول ما أتجوّل فى أىة مدينة جديدة إلى هذه الشوارع
الضيقة، ويا حبّذا تلك الشوارع التى يبلغ من ضيقها استحالة مرور العربات بها. تحضرنى
زياراتى لخالتى ـ رحمها الله - فى سوق السلاح بالقلعة، وأنا حول العاشرة. ما زلت
أعيش الشوارع هناك بسلالمها المتآكلة. أتحسس كيف مازالت ماثلة فى كيانى مع شعورى
بالخوف من أن أتزحلق على أطرافها، كلما خطرت ببالى من جديد. فَرِحْتُ مؤخرا حين
وجدت أن هذا الشعور مازال يراودنى بطريقة أرق وأطيب وأنا أمر يوميا على سوق
السلاح بعد أن انتقل سكنى إلى المقطم مؤخرا. لم أفرد خريطة
أثينا ولا مرة واحدة، بدأتُ رحلة المشى حتى وصلت إلى ما أردتُ دون أن أحدده
مسبقا، هذا هو، فأنا أسير فى مثل هذه التهويمات الحرة بالتوجّه التلقائى دون
خريطة، بقدر ما أسير فى الاستكشاف المنظم بالخريطة والبوصلة. هناك حول المرتفعات
المؤدية إلى الأكروبول، تقع المقاهى على الأرصفة فى جمال طبيعى، والمقهى فى
"بلاد برّه"ـ فى أغلب الأحوال ـ هو مطعم ومقهى وبار وخدمات نظافية
(للإخراج والغسيل)، وهى تحت أمر
وإذن الرواد دائما ـ بل المارة أيضا. إلا أن ما زاد وميـّز أثينا هنا حول
الأكروبول هو تلك الدعوة الحارة من النادل تلو النادل للمارة أن "يتفضلوا"
بالهناء والشفاء، ورغم أنك ستدفع الثمن إلا أن الدعوة تبدو "عزومة"
صادقة بشكل أو بآخر، وأنت تستطيع أن تقرأ خارج كل مقهى/ مطعم أسعار المشروبات
والوجبات الكاملة، والطلبات المنفردة، تقرأها بالتفصيل قبل أن تتورط، وعلى الرغم
من الحديث عن ملايين السياح فى اليونان، فإننى لم أشعر هنا بزحمة أو استغلال. فالأسعار
بالمطاعم تقل عن ما يقابلها فى مصر (إن وجد ما يقابلها) بمقدار النصف أو يزيد،
والبقشيش ليس ابتزازا مقررا، ولا فرق فى الترحاب والوداع بين من يعطى أكثر ومن
يعطى أقل، ومن لا يعطى أصلا؛ ممن لا يستطيع، بل إنى حين اطمأننت إلى أسعار هذه
المقاهى/المطاعم، ونوع المأكولات الحريفة من "محشى باذنجان"،
و"مسقعة باللحم المفروم"، قررت دعوة
زملاء الرحلة لـلغداء، كنوع من البداية السمحة. تناولت مشروبا خفيفا، ولم أعط
النادل بقشيشا لأرى، ورأيت ما ذكرتُ من ترحيب غير مشروط، وبعد لقائنا فى الميعاد
ظُهرا جعل أولادى يتحدثون عن شدة الرخص هنا (بالمقارنة) بأسعار الملبوسات مع
ارتفاع الذوق، وجمال التنويعات. فتألمت لأن مصر كانت دائما مضرب الأمثال فى
الرخص والذوق معا، ودخل الفرد عندنا هو أقل حتما من هذا البلد، فما هى الحكاية؟
أكف نفسى عن التمادى فى هذا الاتجاه. أنا لم أحضر هنا لأضرب وأطرح، ولا هذا وقت
السياسة التى أدّعى الفخر بأنى لا أفهم فيها إلا ما ينفرنى منها، تحدث الأولاد
عن ذلك أيضا وكأنهم قرأوا أفكارى فزادونى غما ورفضا لـلتمادى فى هذه الدراسات المقارنة. هل هذا وقته
أو مكانه؟ حدثتهم عن جولتى وعن دعوتى لهم على الغداء. فرح الجميع لتوفير ثمن
وجبة واجبة الدفع من ميزانيتهم المحدودة، أو على الأقل لتخلّصهم من وجبة بديلة من العيش
"الحاف، والحلو" بسكويت"!!. حين ذهبنا إلى
المقهى ذاته قرب الأكروبول عبر الشوارع الضيقة المثيرة، شرحت لهم كيف اكتشفته،
وكيف هدتنى تلك الشوارع إلى الطابع الخاص للبلد الذى نزوره، وضحك أولادى الذين
صحبونى فى مثل ذلك إلى جنيف القديمة، وتذكروا فرجتهم سابقا على سكنى
بالمونمارتر، وشوارعه الضيقة الصاعدة باستمرار. لم نعرف أسماء
الأطعمة باليونانى (طبعا)، فدخلنا
إلى الواجهة الزجاجية المحيطة بالعينات، وأشار كل منهم إلى النوع الذى يحبه،
وحين سألنى النادل هل هؤلاء كلهم أولادى، أجبت بالإيجاب، دون أن أشعر أننى أكذب.
وحين جاء وقت الحساب مال علىّ، وقال إنه مجرد عامل وليس صاحب المقهى، وكدت أقول
له: إذن لماذا كل هذا الإخلاص والحماس والدعوة والدعاية والود والحرارة؟ كنت قد
نسيت أنّ مَن أخذ الأجرة حاسبه الله على العمل، كما كان الأمر عندنا منذ سنين،
وأن من أكل عيش اليونانى يضرب بسيفه (بعد التحوير)، قال الرجل، وهو يعتذر عن عدم
استطاعته أن يعمل تخفيضا خاصا لى يناسب هذا العدد الهائل من الأولاد والبنات،
أنه مجرد عامل، ثم أصرّ أن يتنازل عن "بقشيشه" إشفاقا على، بل إنه رغم
هذه المقدمة والاعتذارات، عاد فتبرع عـلى مسئوليته وعمل تخفيضا خاصا فى نهاية
الأمر دون طلب منى، وتكلف الواحد منا ما لم أتصوره فى بلد سياحى فى مكان سياحى،
فى حضن الأكروبول. أدركت من كل
ذلك أنه ليس ثمَّ افتراض هنا أن السائح هو ثرى بالضرورة، وأنهم يدركون أن الشطارة السياحية ليست هى أخذ أكبر
مبلغ من المال من هذا الغريب الذى لا يعرف شيئا عن حقيقة الأسعار، والذى قد لا
يقابله الشاطر إلا مرة واحدة طول العمر. رجحت أيضا أن ما فعله معنا هذا النادل
تلقائيا لا يمكن أن يكون تخفيضا لتكوين زبون، أو لكـسب لاحق منتظر منى، فهو يدرك
تماما أن مثلى قد لا تخطو قدماه هذا المكان مرة أخرى، وإنما هى علاقات إنسانية
مضبوطة بجوهر مصالح أعمق، فى إطار من حرارة ود البحر الأبيض، وهو التزام خلقى هو
ـ فى النهاية ـ مكسب للجميع، الزبون والعامل وصاحب المحل والبلد المضيف والدعاية
المستقبلية. نعم. ليست المسألة حذقا وشطارة عاجلة، بل هى بعد نظر، وانتماء واع،
ومكسب مضمون عمره أطول. استأذنت منهم،
وحملت مشتريات أفراد الرحلة معى "وحدى"، عائدا إلى الفندق قبلهم؛
لأرتب خط سيرى غدا، وأعيد تنظيم أفكارى، تاركا لهم "بعد الظهر"
لاستكمال ما شاؤوا من مشاهدة ومقارنة وتعلم وانبهار. كان الحمل ثقيلا؛ لأنه حوى
بعض مهمات التخييم فى المعسكر، وسألت ـ بالإنجليزية ـ أحد المسنين الواقفين
بمحطة الأتوبيس، عن رقم الأتوبيس الذاهب إلى المطار (حيث الفندق بالقرب منه)،
فأجابنى بعد أن أطال النظر إلى وجهى، أجابنى بالعربية دون الإنجليزية، هكذا بحدس
سليم. وكان أولادى قد حدثونى عن أصحاب المحلات الذين جعلوا يحدثونهم بالعربية عن
ذكرياتهم فى الإسكندرية، وأغلبهم يذكر عبد الناصر ذكرا غير حسن، وقد تمادوا فى
تفسير طردهم (هكذا صوّروا خروجهم من مصر) بأنه ـ الله يرحمه ـ كان يكره
المسيحيين. وإذا كان معهم حق فى تفسير تضييق الخناق عليهم، حتى تفضيلهم المغادرة
مما أسموه طردا، فإن تهمة التعصب الدينى لا تليق على عبدالناصر بالذات. راح عبد
الناصر، و ترحم الجميع على
"أيام"، وأمِلوا فى "أيام"، وندموا على تصرفات، وبقى الود،
والحلم. قال لى العجوز
اليونانى: كيف حال الناس فى مصر؟. قالها وكأنه يسأل عن أهله لا أهلى، قلت له:
بخير"يجتهدون" ولكنهم كثير. قال: أعلم ذلك، قضيت هناك كل عمرى. لم يقل
نصفه أو أغلبه، وكأنه يعتبر أن ما جاء بعد ذلك (بعد عودته هنا) ليس من عمره، أو
هو شىء جديد لا يصح جمعه إلى ماسبقه، سألته ما رجّحته، هل كنتَ فى الإسكندرية؟.
قال: بل "الكاهرة" ولم يقل مصر، مثلما نسمى نحن القاهرة، فهو يميز
بدقة أصح ما بين كلمتى مصر (القطر)، والقاهرة (العاصمة). وظل يسألنى عن اسم
الفندق الذى أريده، وأحاول أن أُفهمه أنى أعرف أنه بعد محطة المطار مباشرة،
وأننى لست فى حاجة إلى أن يتعب نفسه بمحاولة إفهام السائق أن ينزلنى حيث ينبغى،
ولكنه يذهب للسائق بمجرد توقف العربة وقبل أن أركب، ويرطن معه، ثم يأتى يطمئننى،
وينظر إلى حمولاتى المخيمية الثقيلة، ثم يشفق علىّ - وكأنه أبِى حين كان يوصى
سائق العربة الأجرة الذاهبة إلى بركة السبع أن ينزلنى فى الموقع السليم؛ حيث
تاكسى طنطا. شعرت أننى استدفأت بأبوة حانية كنت أحسب أنى استغنيت عنها من فرط
ممارستى دور الأب دون الابن فى مهنتى وتدريسى وأسرتى جميعا، وتصورت أنه لم يبق
أمام هذا اليونانى السمح، إلا أن يواصل الركوب معى؛ حتى يوصلنى إلى الفندق
ليطمئن على، وهو يحمل عنى بعض أشيائى، وتساءلت ـ كما تساءل أولادى من قبل ـ لمَ
يعاملنا الناس بكل هذه الرقة والدماثة؟. هل لأنهم كانوا عندنا؟. هل لأننا
نذكّرهم بأيامهم الحلوة هناك؟. هل لأننا أكرمناهم فهم يردون الجميل؟. هل لأنهم
هم هكذا ونحن الذين لا نعرفهم؟. وهل يا ترى نحن ـ أيضا ـ هكذا كما يصفوننا؟.
أعنى هل مازال أغلبنا هكذا؟. أم حدث الشىء؟؟ بل حدث الشىء فى الأغلب: عنف
النقلات تأتى من أعلى، بلا إعداد أو استعدادٍ تحتىّ أعم، مع التمادى فى قلة حزم
الحكومة وقلة خدماتها معا، مع استيراد مظهر الحضارة دون روحها، مع تغير فئة
القادرين ماديا بسرعة يصعب معها تغيير الأخلاق إيجابيا أولا بأول، ومع ذلك
فالطريق طويل. ولا محل للتسرع فى الحكم. لولا أننا كرام بررة، لما تركنا كل هذا
الأثر على هؤلاء الناس. وأتساءل كما تساءلت عن لبنان من قبل: هذا بلد غنى: زراعى
صناعى إلى حد ما، سياحى ـ تاريخى ـ عريق، فلماذا كانوا يهاجرون؟ لا أكاد أصدق أن
الحاجة المادّية هى التى كانت الدافع الأول أو الأساسى لهذه الهجرة إلينا خاصة.
ولا أظن أن اللبنانيين قد هاجروا إلى أمريكا الجنوبية، فأمريكا الشمالية
ونيوزيلندا مؤخرا للسبب المادى ذاته، وإذا كان المصريون حاليا يهاجرون لأسباب
مادية فى الظاهر فقد يـُثبت التاريخ أن وراء هذه الهجرة شىئا آخر. على كل حال
فقد عاد اليونانيون إلى بلادهم ورحلنا نحن وراءهم، إلى هناك، ومع أنى دخلت
اليونان هذه المرة من باب مصرى سورى، إلا أنها ظلت متميزة بما هى، وقد كان
الفندق السورى الذى أقيم فيه ـ على الرغم من تواضع إمكاناته ـ هو أغلى من مثله
فى سان فرانسيسكو، وبوسطن وباريس ونيويورك، وقد منعتُ تصعيد الاحتجاج داخلى؛
اعترافا بجميل الأم التى رعت أولادى كل تلك الرعاية فى غيبتى. لكننى قارنت بين
هذا التعجيل للكسب، وبين موقف الصينيين وأولاد عمومتهم (من كوريين
ويابانيين..الخ)، حيث يبالغون فى الرخص، بالمقارنة بالأسعار المحلية، حتى يخيل
إليك أنهم يخسرون، ومع ذلك يستمرون وينجحون. وهممت أن أنبه السيدة السورية
(الأم) إلى أن هذا الموقف اللاهث نحو المكسب السريع، فيه قصر نظر على المدى
الطويل، ولكنى خفت من سوء تفسيرنصيحتى. فالفندق نزلاؤه قليلون، والأعمال حولى
تدل على أنها أعمال صفقات واتفاقات كبيرة لا أفهم فيها كثيرا، فما أدرانى أنا
بما هم أنجح فيه وأقدر. ولكن شعور عابر سبيل مثلى يرى ويقارن، لا يمكن إهماله،
حتى لو كان مثلى لا يفهم فى لعبة رجال الأعمال، إلا بمقدار ما يفهم صديقى
"عم فتحى" الميكانيكى فى حل ألغاز الشطرنج. طيب بالله عليكم : أنا
مالى؟ الجمعة 24
أغسطس 1984: بدأنا السفر
فى ساعة مبكرة. الجو شديد النقاء والإنعاش، وكانت المشكلة هى فى الخروج إلى
الطريق السريع، دون أن نتوه داخل أثينا وقد نصحنا ابن السيدة السوريّة صاحبة
الفندق أنْ:" ضلّك ماسك البحر. ضلّك ماسك البحر"، مع أن البحر هنا
(الكورنيش) لا يسمح لراكب سيارة أن يظلّ ماسكه، مثلما يمكن أن يحدث عندنا من
شبرا الى حلوان. لكنى اتبعت النصيحة على قدر الاستطاعة. فخريطة أثينا التى معنا
هى خريطة داخلية أساسا، ليس فيها ما يبيّن السبيل إلى الخروج إلى الطرق المحيطة، بدأ السفر
البرى الواعد. كنت قد اتفقت
مع أولادى أن يتناوب كل منهم الجلوس بجوارى كمرشد، أعطيه خريطة المنطقة التى
نعبرها، وأحدد له بلد القيام ومحطة الوصول التالية، ونتفق على الطريق، وعلى
أسماء البلاد التى سنعبرها بالتتالى، ونحدد المسافات بمقياس الرسم، ونعدل عداد
الكيلومترات على الصفر، وننطلق. واعترض أغلبهم، فهذا لا يحب الجغرافيا، وتلك لم
تمسك بخريطة من قبل قط، وهذه تريد أن تنام، وكان لا بد أن أصدر أمرا بالتناوب
دون اختيار، ومن لا يعرف شيئا عليه أن يتعلمه، لأن ذلك جزء لا يتجزأ مما اتفقنا
عليه، وبمجرد بداية التجربة وجدتْ المرشدة الأولى متعة وإثارة فى قراءة
اللافتات، والسؤال أحيانا بالإنجليزية، وأخرى بالفرنسية، لكننا نتلقى الإجابة
دائما باليونانية، وينهمك الشخص المسئول بإخلاص متفان فى الشرح باليونانية، رغم
وضوح أننا لا نفهم شيئا، ولا يربط بيننا وبينه إلا نطق اسم البلد، وربنا يستر أن
يكون النطق صحيحا؛ ذلك أن درجة مطّ الحروف يفرق حتما، فحين سألنا عن لامْيَا Lamia، كما قرأناها بالإنجليزية، تعجّب المسئول الواحد تلو الآخر،
حتّى رجّح أحدهم ما نعنى، فإذا به يرفع حاجبيه ثم ينطقها صحيحة "لا
مِيييااا، بمدّ الألف، ومد الياء، أكثر، ثم مط الألف الأخيرة، فـنبتسم ونقول
(بالإشارة) هى كذلك، وكأننا نشير إلى ما قال دون أن نجرؤ على إعادته، حتى لا
يرجع فى كلامه. والحقيقة أننا أدركنا بعد قليل أن علامات الطريق شديدة الوضوح،
شديدة الدقة، كنت دائما أتعجب من افتقار طرقنا لمثل ذلك (تذكّر التاريخ!) اللهم
إلا تحذيرات السرعة، وأنه" على الأجانب ألا يخرجوا من الطريق
الرئيسى"!!! ( لا يا شيخ!! ! يخرجرون إلى أين؟). نمضى فى طريق
متسعة بعض الوقت، تضيق رويدا رويدا حتى تصبح طريقاً مزدوجة عادية، لكننا ندفع
دائما ثمن المرور عند بوابات تحسب المسافات، (كما حدث عندنا مؤخرا مع الفارق)
ويأخذ الطريق رتابته المكرورة، ولا يبقى منتبها إلاىَ والمرشدة الصغيرة، أما
بقية أفراد الرحلة فسرعان ما راحوا يغطون فى نوم عميق. أنتبه إلى أن الطريق ليس
رتيبا كما أوحى لى نومهم، وأبدأ حوارا مع مرشدتى عن الجمال والخضرة من حولنا.
الخضرة فى المرتفعات والسهول وكل مكان، وأكاد أقول لها إننا أخطأنا ونحن نقول إن
مصر بلد زراعية، وإنها هبة النيل؛ لأن هذه البلاد هنا هى هبة الله مباشرة، دون
وساطة لنهر أو دورات فيضان. وتكاد ترفض الصغيرة أن أحرمها من التمتع بالجمال
بثرثرتى وإصرارى على تقليب آلام المقارنة، وأعترف لنفسى مكررا أننى فعلا أحرم
نفسى كذلك من حقها فى مواجهة هذه الطبيعة الرائعة دون وصاية العقل أو حقد
الحسرة. قد يكون
مناسبا أن أعترف أنى أتصوّر أحيانا أن غلبة تفكيرى هكذا تجعلنى عاجزا عن المتعة
الخالصة، حتى أنى اعتبرت نفسى أحيانا ممن يفتقرون إلى قدرة معايشة اللذة المجردة
مما يسمّى عندنا، نحن النفسيين، اللاهيدونيا anhedonia. وحتى مع اعترافى بهذا العجز عن اللذة الاختيارية، أو الوعى الكافى
بها، فإنى أعترف أن مسام إدراكى، أذكَى منى وأطيب، فهى تسمح أن يدخلنى الجمال
والتناغم بلا استئذان، وأن يطفوا على إنتاجى وتوجُّهى فى أغلب نشاطاتى. وها هى
الفرصة: أن أحاول أن أجعل أروع مافى هذه الرحلة هو أن أتدرب على ألا أكون بعدها
ومن خلالها "كما كنت" "قبلها. أن أتوقف عن الخوف من الاستمتاع،
ألا أكتفى بالمتعة بأثر رجعى، لابد أن أتعلم
كيف أبدأ فى الاستمتاع "الآن" وبوعى مناسب.
أليست الفرصة
الجديدة ينبغى أن تكون جديدة فى كل شىء؟. يمرق منّا بين
الحين والحين موتوسيكل (تعمدت عدم الترجمة إلى دراجة بخارية!!) يركبه فارس،
وأحيانا تمرق كوكبة من الفرسان معا، وكأنهم يتسابقون، وأقدّر ـ بالمقارنة
بسرعتنا ـ أن سرعة هؤلاء الفرسان لا تقل عن مائة وخمسين كيلومترا فى الساعة،
وربما مائتين. أتساءل عن هذه الوسيلة التى بدأت تتزايد بشكل يدعو إلى الدهشة
(يدعو مثلى على الأقل إلى ذلك)، أهو وفر للوقود؟ أبدا، فهذه الموتوسيكلات
السريعة تصل سلندراتها إلى أربعة، وسعتها لا تقل عن سيارة صغيرة، فما الحكاية؟.
وأتصوّر أن هذا الاتجاه الأحدث هو بمثابة عودة إلى الفروسية لا بد أنها تُـشعر
الراكب بنشوة الاختراق الحاسم، والقدرة على المواجهة بالجسد، حالة كونه
"أنا". كما تحمل معانى التفوق وهو يمضى فى سرعة الشهب ومضاء السيوف.
ثم إنها ـ هكذا سرحتُ ـ تسخِّر التكنولوجيا ضد الرفاهية. فقد تعوّدنا أن عطاء
التكنولوجيا يصاحبه دائما مزيد من البلادة والرخاوة والثبات فى المحل كلما زادت
الأزرار و"التحكم عن بعد". أما هذه التكنولوجيا التى تسمح بكل هذه
السرعة، فهى تؤكد حضور الجسد فى مواجهة الطبيعة بكل اختراق التحدى والتلاؤم معا،
وكلما مرق منا فارس أو فارسة (والتفرقة صعبة أو مستحيلة) دعوت لهم بالسلامة، هم
وأمثالهم مستعملا ألفاظ أمى (روح يا بنى ربّنا يكتب لك السلامة انت واللى زيّك)،
وكأنهم أولادى، فتبتسم (أو هكذا خيّل إلى) مرشدتى الصغيرة، وكأنها سمعت دعوتى. أتذكر نوعا
آخر من رفض دعة التكنولوجيا دون قوّتها وإمكانيات تناسقها مع طبيعة نشطة، وهو ما
رأيت داخل المدن كمقابل للموتوسيكلات خارجها، ألا وهو استعمال قبقاب التزحلق ذى
العجلات، فى المواصلات داخل المدينة. فقد لاحظتُ، حين كنت فى باريس، أنه قد لجأ
شبان وشابات أصغر إلى ركوب القباقيب والانطلاق بها فى الشوارع، وحقيبة
الظهرمعلقة بحبالها إلى تحت الإبطين، ينطلقون بين السيارات فى سرعة ورشاقة،
وكأنهم يرقصون الباليه بفخر وجمال. نعم.. الأمر يحتاج إلى شوارع كالحرير، وأخلاق
كالفولاذ، ولا سبيل للمقارنة بما عندنا من هذا أو ذاك، ولكن ما يهمنى من هذا
وذاك هو الروح الكامنة وراء هذا وذاك، روح الفتوة ورفض الدعة، على الرغم من أن
كل وسائل تكنولوجيا الرفاهية فى متناول الأيدى وللجميع تقريبا، هم لا يرفضون
الدعة وقت الدعة، لا يطيب لهم أن يتمادوا فى التخدير طول الوقت. كيف انتشرت
عندنا شائعة تقول إن الرفاهية دائما هى الهدف؟ هى غاية المراد؟
تصيبنى الحساسية عندما أسمع تعبير "مجتمع الرفاهية"!!. يا
ساتر، الرفاهية عندنا هى الراحة والكسل، وأن يخدمك الناس دون أن تخدمهم.الرفاهية
عندنا هى الهدف من الحصول على الشهادة "الكبيرة"، وهى الهدف من
الانتخابات، وهى الهدف من المكسب، بل من التدين أحيانا. الرفاهية عندنا لا تعنى
اختصار السبل لمضاعفة الوقت، وإنما تعنى فى المقام الأول أو الأوحد: الدعة،
والاعتمادية، والجهد الأقل. طالب الجامعة عندنا الساكن على بعد بضع مائة متر من
كليته، لا يركب دراجة، ولا يمشى، وإنما ينتظر الأتوبيس مهما تأخر، ومهما انحشر.
ومهما كان سيصل سيرا على الأقدام
قبل أى أتوبيس، و الأكل عندنا التهام ممتع غير منتظم، والنوم أفضل وسيلة
للطناش،(واللى تشوفه بالنهار الأكل أحسن منه، واللى تشوفه بالليل النوم أحسن
منه، الله يرحمك يا ستى أم أمى!!). ما حكايتى مع المتعة ؟ مع الفرحة ؟ مع
الرفاهية ؟ هذه شىء وتلك شىء ، أما الرفاهية فأنا حَذِرٌ طول الوقت من مجتمع
الرفاهية بهذه الصورة الشائعة، حذر لدرجة الخوف، أخاف من أى كسل فيتهموني بادعاء
التقشف، تقشف ماذا يا جماعة؟
أكتب هذا الكلام الآن
-أثناء مراجعة الطبعة الثانية، يوليو0002- وأنا أعيش فى رفاهية جهازالتكييف
مضطرا،حلة كوني لا أطيقه، هل معنى ذلك أننى ضد الاستمتاع كما أتهم نفسى
دائما؟ ليكن، أفضل عليه مروحة
السقف مهما قالوا إنها "بلدى" تفسد (فى حد زعمهم) كل الجمال المصنوع
(الديكور) داخل الحجرات اياها.(قمت أغلقتُـه وأدرتُها!!.) أذكر كيف
انزعجتُ حين ركّبت جهاز تكييف فى حجرة مكتبى بالعيادة دون حجرات الانتظار.
تصورتُ أيامها أن كلامى للمرضى كذب بقدر ما هذا الجهاز هو كاذب، يصنع واقعا
غيرالواقع. تصورتُ أن ما أقوله لمرضاى فى درجة حرارة معينة لا بد أن يختفى بمجرد
خروجهم من حجرتى ومواجهتم بدرجة حرارة الواقع. عن أمى عن أمها أنها كانت تقول : "كلام الليل مدهون
بزبدة، يطلع عليه النهار يسيح ". أرجح أنها كانت تلمّح للوعود التى يعدها
الأزواج استرضاء للزوجات ليلا،لتحقيق أمل الجنس البشرى للحفاظ على نوعه، ثم، متى
طلع النهار، كلٌّ ملهى فى حاله، وحين تعطل جهاز التكييف هذا فى العيادة (كنت
اشتريته قديما مستعملا جدا) لم أصلحه لمدة عشرات السنين ، حتى نزعته خردة وكأنى
أخلع ضرسا مسوسا، عدت مؤخرا إلى الاستسلام لجهاز جديد بعد أن صار وجودى بالعيادة
لـلمشُورة والمتابعة وليس أساسا للعلاج والمواجهة. أُطلق على
الهواء الذى يصلنى من جهاز التكييف صفة
"الهواء البلاستيك"، وحين فُرض علىّ فى بيتى جهاز خاص أيام
حساسيتى المفرطة من كل نعومة واستسهال، هاج علىّ ما يشبه الهجاء بعنوان :
"لدائن اللذات والشبع": :أدرتُ زر النسمة العليلة، روّضتُ لـيْـث
العاصفةْ،......، بحثتُ عن شوق قديمٍ غامضٍ، عن بغتةِ المواجهةْ، عن حفز صدِّ
القدرِ، عن ثورة الجلود والمشاعرِ، فغاصت الأناملْ، فى خدر لهفـةٍ مهلهلةْ،
وذابت القلوبُ فى رخاوةِ الدّعةْ. رعبى الشديد
من الدعة، من الرفاهية، هل هو رعب أم رفض أم خوف؟ أنهيت هذا الخاطر بإعلان خوفى
أن يكون الاستسلام للدعة هو تراجع عن
شرف التساؤل، عن الملامح الحريفة، عن تفضيل الطبيعة البلاستيك على
الطبيعة الطبيعة ، أنهيت هذه الصيحة
وكأنى أنعى نفسى، أو أرثى عصرى، قلت "... ترسّخت قواعد المداعبةْ،
توارت الأهلةْ، فى عتمة الرفاهيةْ،.......تناسخت لدائن اللذاتِ والشبعْ، وضابط
الإيقاعِ صمتُ الوعى، والمداهنة،......، تخبو الملامح الحريفةْ. يتوه وجه الشمس خلف المدفأةْ." أكتشفُ أن ما
كتبته مما تصورته شعرا، هو أقرب ما يكون إلى ما هو سيرة ذاتية، (هذا الاكتشاف هو الذى أضاف إلى هذا ما أسميته:."ذكرُ
مالاينقالْ" حيث قررت أن
أجمع ما ظهر منى عفوا، مما اكتشفت
لاحقا أنه ليس إلا سيرتى
الذاتية الأصدق. أنظرالترحال الثالث إن شئت). ربما كان هذا
الشعور المستمر بالخوف من الدعة، ومن ثمّ بادّعاء التقشف، هو الذى يكمن وراء
تفضيلى التخييم على فنادق الخمس نجوم، وأيضا هو الذى يفسر تلك القواعد الصارمة
التى أفرضها على أولادى، والمبالغ الزهيدة التى أعطيتها لهم فى هذه الرحلة.
ربما.حلول فردية، وشبهة كذب. لكن: ماذا أفعل؟ - دعونى أحاول حتى لو كنت أخدع
نفسى. هذا بعض حقى، وهو بعض زادى لأستمر. يمرُق بجوارى
فارس وفارسة. أعلم هذه المرة أن من تركب خَلف القائد هى فارسة. علمتُ ذلك
بالصدفة، ولا أقول كيف، أنا أركب الموتوسيكل أحيانا حتى الآن، بل إننى اشتريت
موتوسيكلا حديثا ما زال قابعا ينتظرنى بعد أن حالت دون استعماله، فورا، تلك العملية التى
أجريتُها لغضروف ركبتى مؤخرا؛ وأسفتُ أنه ليس له "مارشا" أتوماتيكيا. أنا أفهم كيف
يضبط فارسٌ توازنه على هذه السرعة الفائقة، لكن أن يحمل السائق وراءه آخر، فضلا
عن أخرى، و ينطلق هكذا بهذه السرعة، فلا بد أن يلتحما ويتفاهما ويتناغما حتى
يصيرا واحدا. ما أروع الفروسية الجديدة وأصعبها. أضيقُ بهؤلاء النيام خلفى داخل
حافلتنا، عدا المرشدة الصغيرة التى هى مضطرة لليقظة حسب الاتفاق. وأسأل: أليس
السفر نفسه هو الرحلة؟. أم أن الوصول إلى المحطة القادمة هو غاية المراد؟
تعلّمتُ بعد طفرة من طفرات مراجعاتى أن أرفض حكاية "الوصول" هذه،
فأصبح الغرض من السفر يتحقق عندى منذ دوران مفتاح العربة فى بداية الرحلة. أنا
حين أسافر أصل قبل أن أرحل، حتى أننى اعتدت أن أبدأ رحلاتى مع زوجتى إلى
الإسكندرية مثلا بالجلوس فى أحد أركان فندق فى أول الطريق الصحراوى. وكأننا
أنهينا الرحلة ولسنا نبدؤها؛ ذلك لأن الغاية عندى تكمن فى التحريك ذاته الذى
يبدأ بمجرد عقد النية. أنظر إلى
مرشدتى الصغيرة آمِلا ألا تكون قد قرأت أفكارى، فأنتبه إلى ماتتطلع إليه. ألاحظ
تجمع سيارات فى مكان شديد الجمال، متوسط الارتفاع؛ مما يوحى بوجود شىء خاص
يستأهل هذا التجمع. أتوقف، ويستيقظ النيام لننزل، فنرى. فى مثل هذه
الرحلات بلا دليل، ولا خطة محكمة مسبقة، دع رجليك، وعجلة قيادتك تقودك إلى
التجمعات الصغيرة (والكبيرة أحيانا)، ودع سيارتك تأتنس بأخوات لها فى الطريق،
وتوَقَّــفْ حيث يتجمع هؤلاء أو أولئك، وإنك واجدٌ ـ بالصدفة ـ ما ينبغى أن تراه
دون أن تحدده مسبقا. فالناس إذا أطلقوا طبيعتهم النقية بعيدا عن مشتريات المدن
والحوانيت العملاقة، لا يتجمعون إلا على جمال و خير. وقد كان. نزلنا، وهبطنا
مع الهابطين إلى حضن الجبل، والغدير يتهادى تحت قدميه. الفاكهة تباع زهيدةً
أسعارها دون استغلال فرصة وفرة السياحة. المعابـر الخشبية تتراقص تحت أقدام
العابرين كأنهم يرقصون جماعة. الناس يشترون الذكريات ظاهرا، ويمشطون الوعى
الراكد فى سرية منعشة، وهم يتمتعون بالصحبة والدفء، دون وصاية أو صفقات. (ما زلنا)
الجمعة 24 أغسطس 1984: لاحت الحدود
عن بعد، وتوقفنا عند آخر محطة بنزين، نموّن، ومحطات البنزين، مثل المقاهى، هى
لخدمة الناس والسيارات. هى مقاه ومطاعم وخدمة متكاملة، وأحسب أن تقديم خدمات
النظافة البشرية (الإخراج) هى حتمية فى مثل هذه الأماكن بحكم القانون، نظافة هذه
الأماكن المخصصة لهذه الوظيفة العظيمة هى المقياس الدقيق لشعور الناس بالناس.أنت
تقضى حاجتك وراء باب مغلق، فى مكان سوف تتركه ليدخله غيرك حتما، فهل تتركه كما
وجدته، أو أفضل مما وجدته؟. أم كما تعرف وأعرف؟. كنتُ كلما ثرت
على النموذج الغربى للحياة، أحاول أن أذكّر نفسى بالخطأ المغرور هذا، فأصحبها
لأشكُمها (كلمة عربية) بأن أذهب إلى مراحيض عامة توجد فى أول المنيل بالقرب من
السنترال هناك، أمام محل المرحوم عم محمد حسن 'سمكرى' العربات، وأقول لنفسى:
أليس هذا نحن؟. فلتعرف حدودك يا فتى (أنا الفتى!!) قبل أن تتمادى فى الهجوم على
الخواجات "الذين هم"، فما دامت مراحيضهم أنظف من حجرات الصالون عند
أكابرنا، فهم أسيادك يا فتى (أنا مازلت ذلك الفتى الغِرّ!!!)، فأوقفُ هجومى
عليهم، إلى حين، أى إلى أن أتبين أننى لست "فتى"، وإن كنت غِرّآ، كما
أتبين أن هذا ليس هو المقياس الوحيد لـلتقدم الحضارى، حتى لو كنت أهتدى فى بعض
المساجد إلى "الميضة" بحاسة الشم، والعياذ بالله، فإننى أرفض ـ رغم كل
ذلك ـ أن يكون الوضوء، الذى هو إعلان لضرورة تكرار النظافة، هو المبرر لكل هذه
القذارة. لا ليس ذنب ديننا هذا كله، ولكنه التخلف، ديننا يؤكد على الإتقان
والأمانة وإزاحة الأذى عن الطريق (وليس فقط فى المراحيض) وكلام كثير لا أريد أن
أكرره، أشعر أن خجلا ما يجعـلنى أهرب من التمادى فى المقارنة، مقارنة، مقارنة،
مقارنة، الله يخيبنى، بطّل. كفى!! الله!!!! (لم أقرأ رفاعة الطهطاوى . أحسن!)
دخلنا محطة
البنزين وعملنا كل ما تـتصوره. اشترينا ما قد نحتاجه فى أول بلد شيوعى سندخله فى
رحلتنا (تذكّر التاريخ من فضلك)، ووجدنا كل شىء متوفرا، حتى ملء أسطوانة بوتاجاز
المخيم الصغيرة. وحين اتجهنا إلى الحدود بعد حوالى نصف ساعة، وجدنا الصف قد امتد
إلى أكثر من كيلومتر. انتظمنا فيه، وسرعان ما انتظم وراءنا من العربات مثلما هو
أمامنا ـ على حد الشوف ـ وقالت ابنتاى الـلتان زارتا روسيا فى العام قبل الماضى
(مايسة ومنى السعيد)، إننا لا بد أن نُخطرهم بكل ما معنا من عملات، وأن نحتفظ
بورق تغيير العملة طول الوقت، و.... و... إلخ. فهمت كل ذلك وأدركت مغزاه،
واستعددنا له بكل أمانة، فما نحن إلا عابرو سبيل، ولم يكن فى خطتنا البقاء فى
يوغوسلافيا طويلا. ويطول الانتظار حتى تضطرب حساباتنا، فقد صرنا بين العصر
والمغرب، ويتبين لأولادى معنى رخصة "الجمع والقصر" فى السفر،
ويتناقشون فى هذه المسألة، ويكاد بعضهم يضيف تفسيرات عصرية، وشروطا جديدة تصعّب
استعمال هذه الرخصة . يقول أحدهم مازحاً: لا جمْع ولا قصر إلا فى مخيم، فترد
أخرى: أو على قارعة طريق.
كان فى تصورنا
ـ وحساباتنا المبدئية ـ أننا سنصل بلجراد فى اليوم ذاته، وتبيّنتُ ماكنت أعرفه
من جديد، وهو أن مثل هذه الرحلات لا يحسب لها بعدد الكيلومترات تقسم على سرعة
السير، وإلا أصبحت الرحلة هى السخف بعينه، فضلا عن أنها حسبة خاطئة أصلا. أذكر أننى فى
طريق العودة، سألت نادلا فى محطة بنزين فى أعلى جبال سان كلود برنار فى سويسرا
عن المسافة بيننا وبين أيوستا، أول الطريق السريع، فابتسم وهو ينظر إلى سيارتنا
وقال ساعة ونصف، أو أقل قليلا، قلت. له إننى أسأل عن الكيلومترات، فابتسم وصمت.
وحين غادرت المقهى (الاستراحة) وجدت علامة قريبة تقول إن المسافة هى خمس وخمسون
كيلو مترا، فتعجبت كيف نقطع هذا القدر الضئيل فى ساعة ونصف. ثم سرعان ما تبينت
دلالة إجابة النادل بالساعات لا بالكيلومترات. ذلك أننا وصلنا أيوستا ـ دون توقف
ـ بعد ما يزيد عن ساعتين بالتمام، كان الطريق ثعبانا يتلوى بين القمم، أذكر بعض أهل
بلدى حين كنت أسأل أحدهم عن " كم بينك وبين زفتا"؟ (مثلا). فيجيب:" ثلاثة قروش "، فأدرك
أن "كم" لـلعدد، وأن العدد الذى يهم أهل بلدى هؤلاء هو عدد القروش
التى فى جيبه،، لا عدد الكيلومترات، ولا عدد الساعات. تتقدم قافلة
العربات رويدا، تصل عربتنا إلى نقطة الحدود. ثـَمَّ شعور غريب حين تنقل قدمك على
خطٍّ ما (هو خط وهمى فى الحقيقة رغم عناد الحكومات وسخف الأمم المتحدة) فتكون فى
البلد الفلانى، ثم تنقلها إلى الخلف فترجع إلى البلد العلانى، كنا نلعب هذه
اللعبة سنة 9691، ونحن فى جنوب فرنسا فى الباسك الفرنسى قرب بيارتز؛ حيث يوجد
حول الحدود ما يسمى بالأوبرج الأسبانيولى داخل الأراضى الأسبانية، ثم طريق شبه
جبلى يربط بين فرنسا وأسبانيا، نصله على الأقدام، ونعبر لنشترى رموزا سياحية
وأشياء أخرى، مما فاتنا شراؤه أثناء زيارتنا لسان اسباستيان فى شمال أسبانيا،
ويقول لنا صاحب الأوبرج إن هذه الصخرة الصغيرة، مشيرا بيده، هى الحدود، فيقف
أحدنا وكل قدم من قدميه فى ناحية من الصخرة؛ ليعلن أنه وضع قدميه إحداهما فى أسبانيا،
و الأخرى فى فرنسا، وأتصور أن الرجل يخدعنا، أو لعله يمزح معنا، فأقبل الخدعة
ولا أتمادى فى الشك أو التساؤل، وأفهم أكثر لماذا تـُصر مقاطعات الباسك فى كل من
فرنسا وأسبانيا (بلغتها الخاصة ولهجاتها الخاصة وطباعها الخاصة) على أن تصبح
دولة مستقلة ذات سيادة. هل لأحد سيادة على صخرة؟ ولو !! فمهما
استقلّت الدول أوانـتفخت الذات، بسبب التاريخ واللغة والمصالح والزعماء والغرور
الفردي والعرقى، فسوف تظل هذه الخطوة البشرية البسيطة تعبُر ذلك الخط الوهمى،
الذى يحاول أن يفصل بين الناس وبعضهم، وبين البلاد وبعضها. بعد إجراءات
الخروج الشديدة البساطة التى تمت على الجانب اليونانى، اقـتربنا من السلطات
اليوغسلافية، فإذا بالإجراءات أبسط، حتى أن أحدا لم يطلب منا أن نعلن عمّا معنا
من نقود أو ممنوعات، إذا زادت عن مبلغ معيّن كما فعلت السلطات اليونانية بنا عند
الدخول إلى أراضيها. أنت لا تستطيع ـ عادة ـ أن تميز الناس من بعضهم على الحدود
بين بلد وبلد. فالناس ـ عادة ـ على جانبى حدود الدول أقرب إلى بعضهم البعض من
الناس فى الدولة ذاتها التى قد تختلف فيها اللغة والطبيعة الجغرافية والأصل
العرقى وسبل الرزق على الرغم من
أنهم يحملون نفس اسم البلد، نفس الجنسية. خيل إلىّ ـ مثلما ذكرت حالا عن
الباسْك ـ أن اليوغسلاف على الحدود اليونانية أقرب إلى اليونانيين على الحدود
اليوغسلافية وبالعكس. كذلك الحال مع الإيطاليين واليوغسلاف على الحدود بين
يوغسلافيا وإيطاليا، كما أن جنيف ليست إلا سفح جبال الجيرا فى فرنسا فهى فرنسا،
أو هكذا أعامـلها لولا فرق أسعار العملات، أفلا يحق لى أن أصف خطوط الحدود بين الدول بـالخط الوهمى؟.(إياك أن تسمع
إسرائيل). قال لى جندى
(أو مسئول) الحدود اليوغسلافية وهو ينظر فى جوازات السفر."مصر؟". وضحك
ضحكة ترحيب (على ما أعتقد)، وربما تعجب للأرقام العربية على السيارة، وقلت له:
"مصر "، فعند اختلاف اللغات لا يبقى فى الحوار إلا أسماء البلاد
والأعلام، هذا لو سهّل الله بنطقها سليمة أو قريبة من السلامة. أردف الجندى: "مبارك؟"!!. وكان
الرئيس مبارك قد أنهى رحلة إلى يوغسلافيا منذ أيام قليلة. قلت له "نعم"
"مبارك"، وأحسست أن الرباط القديم بين تيتو وعبد الناصر، ما زال قائما
والساسة فى البلدين يحاولون تحديثه بشكل ما (لاحظ التاريخ نحن فى:4891). فرحت
رغم تحفظات لى سابقة على هذه العلاقة، وعلى كل من المذكورين. ثم أكمل الجندى
بالحماسة والفرحة ذاتها قائلا: "مبارك..حسن Mobarak Good"، ورفع إصبعه الإبهام وهو قابض يده، علامة التأييد
والتكريم والتشجيع. قلت له بفخرالمغترب: "نعم". ولكنه أردف:
"سادات". وغمز بعينه، وقهقه، فقلت له: "مبارك حسن، وسادات
حسن". فقد تعلمت أننى بمجرد أن أغادر بلدى أشحذ انتمائى إلى كل ما تمثله بلدى،أو
يمثل بلدى، من رؤساء وأخطاء، وتاريخ، فأرفض أى همز أو لـمز من غريب حتى لو كان
حسن النية، حتى لو اتفق رأىى الشخصى مع همزه ولمزه، فرأيى الشخصى هذا هو لأهل
بلدى وليس للتصدير. مازلت أذكر فى
رحلة الحج كيف كنت سأشتبك مع أحد السعوديين (الذى لا يمثل كل السعوديين طبعا)
الذى راح يعايرنى، من الوضع مضطجعا، بهزيمة 7691، وكأننا - نحن المصريين ـ
انكشارية المرحوم والده. فراح يقرّعنا على فشلنا فى الدفاع عن حريم سيادته. لم
أدافع عن الهزيمة، لكننى لم أسمح بالنقاش حول المسئول عنها رغم موقفى منه، مادمت خارج بلدى فأنا المسئول عن كل
شىء. أسكتُّه بما ينبغى، وعيّرته بأمواله العاجزة عن ردّ شرفه/شرفنا، بل لمّحت
أنها - الأموال- هكذا- قد تكون المسئولة عما لحقنا. خارج بلدى، كل
زعمائى أبطال، وكل غسيلنا نظيف، ومن يعجبه؟ وأعود إلى
الجندى اليوغسلافى فأجده قد التقط اعتراضى، فسكتَ غالباً دون اقـتناع أن كلهم
"حسن"(Good) ناصر حَسن، وسادات حسن،
ومبارك حسن، (لم يبق إلا أن أضيف: وانا "حسن"،وانت "حسن" .
أنا طريقى وسكّتى طريق حسن، آه. الله يسامحهم)، وعلى الرغم من أن كلامى لم
يعجبه، إلا أنه لم يسحب ضحكة الترحيب، ولا علامة التعجب من على وجهه وهو ما زال ينظر إلى الأرقام العربية على السيارة، ولا
اختفت سماحة التواضع التى قابـلنا بها.
أدركت كم
نخطئ ونحن نحكم على رؤسائنا من
خلال آراء الناس فى الخارج. حين مات السادات ودّعه العالم الغربى كبطل
للديمقراطية والسلام، فى حين كان وداعنا له بالداخل وداعا هادئا ناضجا به مسحة
من اللامبالاة (ضع جانبا الـشماتة). كم كتب بعض كتابنا عن شعبية السادات فى
الولايات المتحدة، ولكنه لم يكتب لنا عن شعبيته فى يوغسلافيا أو كوريا الشمالية.
عبد الناصر، استوردنا بطولته من أحلام الإنسان العربى، أكثر من واقع المكافِح
المصري؛ رسموا له صورة البطل
الأسطورى فى العالم العربى، فاستوردها بعضنا كما هى وأضاف إليها من شطحاته ما
شاء. ثم راحت هذه الصورة
المستوردة تفرض نفسها علينا فى الداخل، فنكاد نتمزق بين أحلامهم وواقعنا. عبرنا الحدود،
وغيرنا ما شئنا من النقود، دون سؤال أو إقرار، وأعطونا كوبونات للبنزين وكأنها
مقررة بمقابل معقول، ولم أفهم حينذاك لماذا هذا الإجراء، وتصوّرت أنهم يوفرون
علينا بذلك نسبة معينة، ومع ذلك لُـمتُ ابنتى ،التى قامت بتغيير العملة، على
شرائها كل هذه الكوبونات، فمن يدرى كم سنصرف، وكم سنركب، ثبت بعد ذلك أنى ـ فعلا
ـ "أعترض والسلام" (تهمة زوجتى لى باستمرار). ما كاد نصف
ساعة يمضى، أو ربما أكثر قليلا، حتى فوجئنا بالطريق تضيق، والجبال تظهر. ومن أسف
أننى اهتممت فى رحلتى هذه بخريطة طرق المواصلات، أكثر من اهتمامى بخريطة
التضاريس الجغرافية، وكنت أحسب أنه لا توجد إلا خريطة واحدة لكنى عرفت فيما بعد
أن خريطة التضاريس ذات ألوان محددة الدلالات تعرّفنا بمدى الارتفاع فى مختلف
البقاع. لم تكن مسألة الارتفاع مجرد مفاجأة غير محسوبة، حين واجهت صعوبة فى
سيولة انطلاق السيارة، رغم وزنها المتوسط الثابت، رجحت أن يكون ارتفاع الحِمل
فوق السيارة، دون تناسق جانبيه هو السبب فى "عدم السحب"، وربما
"عدم الاتزان". رجحت أيضا، أن يكون السائق (شخصى الفقير إلى عطفكم،
ورؤيتكم لا رأيكم) هو السبب، علما بأنى قد سبق لى القيادة فى المرتفعات فى
أوروبا ليلا ونهارا دون مشاكل.
أذكر كيف ذات
ليلة من فرانكفورت إلى باريس فى طريق "وطنى" (ضيق مأهول بين المدن
الصغيرة وداخلها) بدءا من بَعد المغرب، وصولا إلى باريس قبيل الفجر، لمجرد أن
نوفر مصاريف إقامة ليلة أخرى فى فرانكفورت. مرّة أخرى، دخلت إلى جبال شامونى بعد
لفة كاملة حول بحيرة ليمان( أو لومان) فى سويسرا، مخترقا طريقا شديد الضيق، شديد
الصعود. لم أكن أخاف شيئا، ولا شعرت بأدنى صعوبة، فما الذى جرى لى الآن؟. فقلت
لعل العربة الصغيرة تختلف عن هذه الحافلة. قلت أيضا: لعله الزمن الطويل بين
الرحلة الأولى والثانية (خمسة عشر عاما). وقلت كذلك: لعلها الزيادة المتعددة
التجلى: زيادة الوزن، وزيادة الأطماع ، وزيادة الجبن، وقلت أخيراً لعله نذير
باحتمال خراب الداخل، وجمود الحركة، بما يواكب ذلك كله من تمادى التصلب. من
يدرى؟ هل هو السن؟ مسئوليتى هذه
المــرَّة مضاعفة لكثرة عدد الرفاق (الرعية)، وثقل الأمانة. لم أحاول أن أعلن الصعوبة
التى أعيشها لمن حولى إلا قليلا..
ابنتى منى يحيى، وهى التى أخذت دور المرشدة فى هذا الجزء من الرحلة،
التقطت هذا الداخل ـ أو بعضه على الأقل ـ لست أدرى كيف، فحكت لى تطمئننى بطريق
غير مباشر، أن هذه العربة ذاتها قد حَسِبتْها (تـَعـوم) منها ذات مرة قريبة، وهى
تقودها فى الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة، ثم نسيَتْ ما حَسِبَتْ، فثبتت
العربة واتزنت فجأة!! وعلمتُ من حكيها هذا أنها تشير إلى داخلى أنا الآن،
وأعطتنى لبانا. أنا لا أحبه، ولا أطيقه فى فمى (أو فم أى رجل) أكثرمن ثوان،
طاوعتها وبدأت المضغ، فاعتدلتْ العربة وتوازنتْ. قالت ابنتى لى، أو قلت لها،
العربة كان ينقصها لبان لا ضبطا ولا زيتا، ولكننى سرعان ما ألقيت ما فى فمى
بعيدا، لم أطقه.ولم تعد العربة للعوم.
نام الجميع من
جديد، إلا مرشدتى، كان الليل قد تسحّب حتّى دخل، لم يعد ثم ما يُرى إلا أضواء
العربات التى لم تقلل من سرعتها. كنت كلما عبرتُ جسرا طويلا بين جبلين، شعرت
بخوف كنت أعيب مثله على زوجتى من قبل.
كنت أعتبر أن من يخاف على نفسه "هكذا"، ومعه آخرون، هو أنانى
يعمل حساب قيمة لحياته شخصيا أكثر منهم، ولكننى حين واجهتُ هذا الخوف الآن لأول
مرّة، على غير عادتى، الخوف من الأماكن المرتفعة، عذرتها، وفهمت أكثر ما نسميه
عندنا (نحن النفسيين) "رُهاب الارتفاع" acrophobia. كنت حتى هذه
اللحظة، ومن أول الرحلة قد ألجمت داخلى بشكل حاسم ، حتّى لا تتسرب منى معالم
الرحلة وآثارها فى التشتت إلى قضايا شخصية داخلية أطماعية، ثانوية عامة، سخيفة،
قابعة ومتجددة، لمْ...ولا تنتهى. فعلتُ ذلك الكف بوعى شائك؛ حتى أتمكن من أن
أقوم بمسئولياتى نحو أسرتى وصُحبتى على الوجه الذى يلزم بلا بديل. على أننى أسمح
لنفسى الآن، وأنا أكتب هذه الخواطر لاحقا، أن أعبّر عن هذا الداخل بما له علىّ،
وما لى عليه: أنا أحب
الحياة بقدر أكثر قليلا من القدر الذى يتحرك به فى داخلى الموت، أحس أنه كلما
زادت ملاحقة حدّة الموت إلحاحا، وكلما زادت علاماته اقترابا، أندفع إلى الحياة
والناس بكل ما أملك، وبكل ما أفعل،
وحين أصاب بإحباط غير محسوب، ومحسوب، وخاصة حين أفشل فى تنافس لا أملكُ
أدواته، ولم أختر معركته، تراودنى رغبة شديدة فى التوقف المناوِر حتى أهدِّئ من
شماتة داخلى، وأفوِّت عليه إلحاحه. ثم أفوّت عليه فرصة الانسحاب حين يدرك أنه
توقـُّف المتحفز لجولة جديدة.
جاءت هذه
الرحلة. وكل ذلك حاضر نشط عندى، لا يعلمه غيري، وإن اطّـلعتْ على بعضه أحيانا ـ
رغما عنى ـ زوجتى. لم أكن أملك
أن أتراجع عنها، عن الرحلة؛ وفاء لوعد سابق، وحرجا من كشفٍ محتمل، ولم أكن أملك
أن أؤجِّل أىة خطوة من خطواتها، فإيقاعها سريع بطبيعة محدودية الوقت مع طول
الطريق وطموح الاستكشاف، وصحبتى معتمدة على خبرتى وحضورى، وما يوحى به وجودى من
قدرات واعدة تجعلهم يتوقّعون كل شىء بما يشبه السحر المغلّف لأساطير بساط الريح
(جميل ومريح)، دون أن يعرفوا حقيقة ما أعايشه، ودون أن يعلنوا مدى اعتماديتهم
صراحة. أنا أعيش كل
ذلك راضيا مختارا منجذبا إلى الحياة؛ هاربا من الموت بداخلى. تراءى هذا كله
أمامى وأنا أرى الجبل إلى جانبى، وعلامة أن هنا منطقة تساقط صخور، وشبكة من
الأسلاك، تشبه شباك الصيادين ، لكنّ يبدو أنها من الصلب المتين، مفروشة على بعض
جوانب الجبل، قال: ماذا؟. قال: لتمنع سقوط الصخور!!.
وعلى الجانب
الآخر، أرى الهوة السحيقة، ويدفعنى اللعين فأدافعه، والعربة بيننا فى حرج بالغ،
وتهدأ السرعة، وأبتعد عن الجانبين ما أمكن فى كل انحناء، فأعطل الطريق. ما أن يعتدل
المسار فأعتدل بالسيارة؛ حتى يمرق منى سيل من العربات التى كانت معركتى مع
داخلى، وضبطى لحركة عربتى، وحركة وعيى معا، تعوق انطلاقهم. بعضهم ينظر، وبعضهم
يعذر. أما الذين معى، فهم يبدون أنهم فى طمأنينة "قصوى" إلى
"مهارتى"، حتى زوجتى التى كانت تقوم عنى بمهمة الخوف فيما سبق،
فأعايرها بضعفها، كانت هذه المرّة مطمئنة (جدا) لقيادتى وحرصى !! لا يوجد مبرر
لأى من هذا والله العظيم، صدقونى.
وسط محاولاتى
المستمرة للضبط، والتحكم، والإخفاء، أسمع بوقا غير مألوف فى عالم الناس
المتحضرة، حيث تكفى إشارات الأنوار ليلا، فأتصوّر أن احتلالى لمنتصف الطريق قد
ضاق به مَن خلفى، حتى واكب الإضاءة بالنفير لينبهنى. ولكن البوق جاء منغما نغمة
ليست غريبة على أذنى، إنها النعمة المصرية التى لم يستطع عبد الناصر أن يصادرها،
البوق يردد "يحيا النحاس باشا، هل معقول؟ أميل إلى أحد جانبى الطريق، فإذا
بسيارة تمرق فى هدوء نسبى ، وترتفع من داخلها أيدٍ تلوّح لنا فى الهواء. تلوّح
بالتحية فعلا. ألمح أرقاما عربية على اللوحة الخلفية
للسيارة (سوريا:.....5 1 3 7..إلخ)، وأعرف أنهم أبناء العم، لمحوا أرقامنا
العربية، ففرحوا بنا كما فرحنا بهم، فانطلقت أبواق التعارُف فتلويحات الترحيب،
وأقول مرة أخرى معانِدا كل موقف سابق: "تحيا الوحدة العربية"!! وأنَحى
كل "لكن" جانبا، فما كان أحوجنى فى هذا الوقت بالذات إلى هذا البوق
وهذا التلويح، وأعود إلى زملاء الرحلة وقد غلبهم النوم فى ظل الطمأنينة لتى لا مبرر لها(!!)، فأزداد مسئولية
وعزما. لكن الظلام يشتد، وأستعين بمرشدتى الصغيرة لتنتقى لنا سيارة نقل، عجوز
وقور، تسير بالقرب من سرعتنا (حول التسعين)، فنركّز أبعادنا على أنوارها
الخلفية، ونحتفظ بالمسافة بيننا وبينها، وننسى أين نسير، وماذا حولنا، ومَـن
خلفنا، وكل ما تفعله سيارة النقل نفعله حرفيا، ومن اقتدى بالخواجة فى بلاد
الخواجات فلا خوف عليه، ولا هو يحزن. وتنجح الخطة، وتختفى الجبال والهوّات فى
عباءة الظلام، ولا يبقى إلا مصباحان مضيئان. فجأة ـ دون أدنى مبرر أو سابق إنذار
ـ يقرر سائق النقل أمامنا أن ينطلق؛ ربما لأنه يحفظ الطريق من قبل، وقد علم أن
وعورته قد خفت، أو ستخف حالا، فتزداد المسافة بيننا ولا أساير انطلاقه، بل أنتظر
فرجا جديدا (عربة نقل أخرى) تعيننى على ما أنا فيه. ووسط الظلام الحالك لا أدرى
إن كنت أسير فى جبل أم فى سهل، ولا إن كان ما بجوارى هوة سحيقة أم حقل أذرة (كنا
نسميه صغارا فى بلدتنا الجبل الأخضر حيث قيل لنا إنه قادر على احتواء، فحماية
لصوص وقتلة الليل فى ثوان). وأغتاظ من النائمين فخورا فخرا سريا بثقتهم فى مهارتى
المزعومة، ومتعجبا من ذلك أيضا، وأزداد بهذه الثقة مسئولية، وبالتالى أزداد قبضا
على الداخل - وحين يزيد غيظى عن فرحى وعزمى أتوقف عند محطة بنزين، بمجرد أن شعرت
أنى قد سرت لبضعة كيلومترات فى طريق مستقيم، حسبت أنه يعلن باستقامته نهاية
المنطقة الجبلية، وكانت الساعة قد جاوزت الحادية عشرة، وتستيقظ القافلة، وأسأل
الرجل قائلا: "كوبون؟ (أعنى هل تقبل كوبونات؟). فيقول لى برأسه وبكلمة لم
أفهمها أن: لا، فحسبت من إجابته أن هذه الكوبونات التى دبّسَتْــَنا ابنتى فى
شرائها على الحدود لها محطات بالذات (قطاع عام مثلا) هى التى تتعامل بها. أما
بقية المحطات فتتعامل نقدا بالدينار (وما أحلى وقع اسم العملة اليوغسلافية
الخوجاتى: دينار)، وأستخسر دفع دينارات صاحية فى البنزين، ويشير عامل البنزين
مستعملا ذراعيه ووجهه وجسمه إلى محطة بنزين تالية، على بعد عشرين كيلومترا ـ كما
فهمنا ـ مرددا:"كوبون" "كوبون"، ثم ينظر فى ساعته ويمط
شفتيه، ولا نعرف لماذا هذه الحركة الأخيرة. وأفـهِّـُم نفسى أنه يعنى أن المحطة
التى تتعامل بالكوبونات تقع على بعد هذه المسافة، ولكن لماذا النظر فى الساعة
ومط الشفاه؟. وتحاول أن تفهمنى إحدى بناتى غير ذلك، فلا أسمع لها، وحين نصل إلى
المحطة التالية أخرج الكوبونات مباشرة، دون سؤال، فيصرف لى البنزين مباشرة (قال
يعنى: أريد أن أحرجه!!)، وأحسب أنى كنت على صواب فى ظنى الأول، إلا أننى أتبين
بعد يوم وبعض يوم أنّ ما فهمَتْه ابنتى، وحاولتْ أن تفهِّمنى إياه دون طائل، هو
الصحيح، وأن الرجل الأول كان يتصور أنى أسأله: "هل عندك كوبونات"؟.
فيقول: "لا" ويشير علىّ بمحطة رئيسية تالية يمكن أن أشترى منها
كوبونات، والكوبونات لا تباع للأجانب إلا بالعملة الصعبة، ولا تباع فى كل محطة،
بل فى محطات رئيسة محددة. ويبدو أن المواطن اليوغسلافى (أيامها) تُصرف له
كوبونات محددة كل مدّة (تموين شهرى مثلا)، بطريقة تساعد على الحد من الاستهلاك،
أو تلزم بعدالة معينة، وأضحك من نفسى، ومن مقالب الحديث بالإشارة، وأعيد فهم مط
شفتى عامل البنزين، وهو ينظر فى ساعته؛ حيث كان يرجّح ـ فى الأغلب ـ أن وقت صرف
الكوبونات قد انتهى فى هذه الساعة، وأحمد الله هامسا: جاءت سليمة بفضل تصرّف
ابنتى على الحدود، ذلك التصرف الذى اعترضتُ عليه دون مبرر، فلولا أن كان معنا
هذه الكوبونات لما حصلنا على حاجتنا من البنزين. يبد أن زوجتى على حق، فقد كنت
"أعترض والسلام". يزداد الليل
ظلمة، وتقل عربات النقل القابلة للمتابعة، وأسأل الركب أثناء فترة الصحو
الاضطرارى فى محطة البنزين: هل نستمر حتى بلجراد ونحن على سفر، منذ ست عشر ساعة
متصلة تقريبا؟. فيقولون: "نعم" توكّل. يقولونها وهم يستعدّون للنوم من
جديد، ويشتد غيظى، فأنا لم أتعب من القيادة، ولكنهم لا يعرفون ما بى، ولا يحسبون
احتمال اانقضاضٍ من داخلى، منتهزا فرصة الظلام والوحدة. ونقف "فى أول
استراحة جانبية"، ونفكر فى أن نُخرج بوتاجاز المخيم الصغير، لنعمل شايا
ساخنا، وندرس الموقف، فما زال أمامنا إلى بلجراد ما يزيد عن ثلاثمائة كيلومتر.
المسألة أن يوغسلافيا كانت فى اعتبار التخطيط للرحلة مجرد طريق، ورؤية استطلاعية
عابرة، ولم نكن قد قررنا أن تكون محل إقامة أو تخييم لصعوبة اللغة، وقلّة
المعلومات عنها. أقول لهم: ليكن، ولكننا سنصل بلجراد وجه الصباح، ثم إننى سأقود فى اليوم التالى مباشرة نفس
المدة تقريبا، "أكثر من عشر ساعات أخرى"، وربما المسافة ذاتها إلى
تريستا (إيطاليا) ففينيسيا، فيقولون: هذا متروك لك، إذا تعبت. أنا علاقتى
بالتعب غريبة؛ إذْ لكى أتعب لابد أن أسمح لنفسى أولا أنه يحق لى أن أتعب. أما
إذا كان هذا السماح غير مطروح، فأنا لا أعرف التعب، فأستمر، كيف؟ لست أدرى. إلى متى؟ أستمر عادة مهما طال الزمن فى
حدود دواعى الاستمرار، والعمل.
وهكذا لم
أتعب، أو لم أسمح لنفسى بالشعور بالتعب، لكن حسابات طاقتى البشرية التى لا أدرك
أبعادها، تخيفنى. ها هم رفاق
الرحلة يصرون على أن يتركوا الأمر لى جملة وتفصيلا، وأكاد أرجح أنهم يفعلون ذلك
استعجالا للعودة للنوم وليس نتيجة فرط الثقة فى رأيى وتقديرى، وكنا قد فشلنا فى
إخراج البوتاجاز الصغير لعمل الشاى الذى كان يمكن أن يدفئ اليدين والصدر، وربما
يحسّن التفكير أيضا، وما إن أنطلق مرة أخرى بالعربة لمدة نصف ساعة لا غير، حتى
يفتح الله علينا بتجمّع متوسط لعدد من العربات أغلبها نقـل، وتستعيد عربتنا
استقلالها مرة أخرى، فتقرر أن تنضم إلى زميلاتها مؤتنسة بالأضواء المنبعثة من
مبنى قريب جميل، فأستجيب لها اتباعا لقاعدة سبق ذكرها، وهى أن الناس ـ والعربات
ـ فى حضن الطبيعة لا يجتمعون إلا على خير وجمال ودفء. وأتوقف وأنا أهدهد العربة،
وأمسح عجلة قيادتها فى رفق، كما كان يمسح الفارس على شعر رقبة الحصان، وهم
يغيّرون الخيل ما بين خان وخان على الطريق، فى روايات الجيب القديمة، أو فى
روايات ديستويفسكى. ومنذ بداية الرحلة، كانت هذه العربة قد بدأت تعلن شخصيتها
المستقلة، وتتلقى عواطف من حولى، ثم عواطفى حين أنفرد بنا الطريق، ولم يعد يقظا
إلا أنا وهى طوال الرحلة. حضرت العربة
بشخصيتها الإحيائية منذ ركبنا المركب، ونحن جلوس فى القاعة الكبيرة المكيفة
الهواء، حين قالت لى زوجتى "إنى أحس بشفقة حانية على عربتنا"، وظننت
أنها تشفق عليها من عددنا أو من الحمولة المنتظرة، فسألتها إيضاحا، فقالت: ها
نحن نجلس وسط كل هؤلاء الناس فى النور والمؤانسة، وهى تحت وحيدة فى البرد
والظلام. ونظرتُ فى وجهها (وجه زوجتى) لأضحك، إلا أننى وجدتها جادة أشد الجد،
فحبست ضحكتى وصدّقتها، ونسيت هذا الحديث، لكننى عدت أذكره حين بدأتْ هذه الصداقة
الخاصة تُعدينى، فراحت العربة تفرض شخصيتها علىّ، فتنمو صداقة جديدة بينى وبينها، ربما من خلال يقظتنا معا،
فهى الوحيدة التى تظل مستيقظة معى طول الوقت تحت كل الظروف فى كل الطرق. كان
عندها ـ العربة ـ كل الحق فى وقفتها تلك . سرعان ما تبيّنا أن المكان هو
"موتيل" ومقهى فى حضن الجبل، وأنه متوسط فى الطريق بين الحدود ومدينة
"نيش" (أكبر بلدة تالية على الخط الرأسي)، وأنه ملتقى قائدى الليل، وخاصة من سائقى عربات
النقل، سواء كانوا قد مالوا، ثم يواصلون السير ليلا، أم أنهم سوف يستريحون هنا
حتى الصباح،. قررت فجأة أن نمضى ليلتنا فى حضن هذا الجبل وسط هؤلاء الناس،
ووافقونى دون نطق حرف واحد. الحجرات نظيفة بسيطة، بها الماء الساخن والبارد
والحمام الكامل المستقل، وسعرها زهيد زهيد.
كان هذا هو
أول موتيل نبيت فيه، ولم أستطع أن أدرك حينذاك هل هو زهيد؛ لأنه فى بلد اشتراكى.
أم أنه كذلك؛ لأن هذا هو نظام الموتيلات عندهم، أو لأن رواده هم من سائقى النقل
المتسببين، وليسوا أصلا من السياح القادرين. بعد أن استقرت
الحال فى الحجرات واطمأننا إلى نومة مريحة، وحمام نظيف، وماء دافئ، وإفطار واعد،
ذهب الأولاد إلى حجراتهم ليناموا أو يتسامروا. نزلتُ وزوجتى إلى الصالة الكبيرة،
وأخذنا نتأمل قادة قوافل الليل وصخبهم وشربهم وضحكهم وانطلاقهم وبساطتهم وقوتهم.
قالت زوجتى إن هذا الجو يذكرها بشىء ما فى فيلم زوربا اليونانى، ولم أسأل ماذا
تقصد، ولكن وصلنى ما تعنيه. أحس أن هذا وجه آخر (غيرالعواصم والمدن) شديد
الأهمية لما هو "أوروبا ". أسميه "أوربا الأصل"، يشمل ذلك
أوربا الجبل، وأوروبا القهوة الّدوّار المرحبة على الطريق، السائقون على الفطرة،
الضحكة المجلجلة دون غيبوبةِ السـُّكـْر، أو سجن المحافظة، العالم الصغير
المتغيّر أبدا، وأحسست بصاحب الموتيل، وكأنه فرح بنا لأننا لسنا من زبائنه
المعتادين. وعلى السلالم، قابلتُ بعض أطفال الأسرة السورية التى حيّتنا فى
الطريق. حين خرجت
لأحضر بعض حاجاتى من العربة كان الرذاذ قد بدأ يتساقط. بدأت أشم
رائحة الجبل،.للجبل رائحة قوية حنون، فملأنى ما ملأنى. قلت لزوجتى فى
فرحة: "هذا هو... هذا هو.". ولم تسألنى ماهذا الذى "هو" "هو".
|
|||
|
Document Code PB.0114 |
http://www.arabpsynet.com/Books/Yahia.B1.1 |
ترميز المستند PB.0114 |
|
|
Copyright ©2003 WebPsySoft ArabCompany,
www.arabpsynet.com (All Rights
Reserved) |